لا يوجد تعليقات
درامية الإنكار: المواربة بين النفي والإثبات في قصيدة حسن النبراوي
رم - لا ليس حباً والذي خلق الورى
لا ليس حبًّا والذي خـــــلقَ الــورى كـلُّ الحكاية ما أراهُ ولا يُــــــــــرى
كلُّ الحكايةِ إن مررتِ بـــــخاطري سلّمتُ ثــمّ ركبتُ دمعًا قد جــــــرى
وبـــــدوتُ طفلًا أورثتْهُ بغنجِـــــها بينَ الحــروفِ تلعثمًا وتـــــــــــعثّرا
بحرُ العيونِ أتــــوهُ فيهِ تشوّقًـــــــا وأنــا الذي رغمَ العواصفِ أبـــحرا
من رافقَ الدمعاتِ نحو خـــدودِها وأقــامَ في غمّازةٍ وتـــــــــــــــسمّرا
وأنا الذي مذ سالَ خــطُّ طـــــريقِه للــخالِ في وجناتِها وتبـــــــــــعثرا
وأنا الذي مذْ ابتسمتْ تـــــجوبُنــي ذكـــراكِ تعرضُ لي بثغرِك سكّرا
فغدوتُ كالمغوارِ ينــــــحرُ خيلَــهُ حتّــى يقيمَ على ضــــــفافِك أشهرَا
لك عَبرةٌ علِقتْ بهُدبٍ خـــــــاطفٍ هي قطرةٌ أحتاجُها كـــي أبـــــصرا
لا ليس حبًّا بل شجارُ خــــــوافــقٍ كطبولِ حربٍ صوتُها مـــلأ الذُرى
جلساتُنا همساتُنا ومـــــحـــــــــابرٌ خطّتْ علــى أدراجِنــــــــا لتذكّرا
كي لا تموتَ على الرفوفِ روايةٌ نــحنُ الشخوصُ ـلـمن أرادَ تفــكّرا
فأنا وأنتِ وليس غيرُك مـــا أرى وجــمالُهُنّ إذا سطعتِ تبخـــــــــّرا
وبهمسةٍ من ثــغرِك العنبــــيِّ لا أبـــقي قلاعًا للأباةِ ولا ثـــــــــرى
لا ليس حبّــًا فالمحبّةُ قــــــــطرةٌ في بـــحرِ مـــا لقيَ الغلامُ وسطّرا
درامية الإنكار: المواربة بين النفي والإثبات في قصيدة حسن النبراوي
قصيدةُ حسن النبراوي تقوم على لعبةٍ بلاغيةٍ دقيقة، حيثُ يبني الشاعرُ تجربتَه على مفارقةِ النفي والإثبات. فهو يفتتح النصَّ بإنكارِ الحبِّ لفظًا، لكنه يغرق فيه معنىً وصورةً حتى أخمصَ قدميه، فيتحقق بذلك سرُّ المقولة: في النفي إثبات.
إذن، القصيدة قائمة على النفي المتكرر لمسألة الحبّ، وفي ذلك مفارقةٌ جاذبةٌ للقارئ، تنبني عليها أركانُ القصيدة التي تدلّ كل كلمةٍ فيها على حبٍّ عالقٍ أنّى له الامّحاء. هذه المفارقة تمنح النصَّ طابعًا دراميًّا؛ لأن القارئ يُدرك أن النفي مجرّد ستارٍ للبوح. وهذا الأسلوب موجود عند العذريين مثل جميل بن معمر حين يقول:
«خَليلَيَّ إن قالت بُثينةُ ما لهُ ... ألا قد أَرى إلا بُثينةَ للقلبِ»
حيث تُظهر هذه الأبيات محاولةَ الشاعرِ إنكارَ تعلّق قلبه ببثينة أمام أصدقائه، رغم أن قلبه ما زال متعلّقًا بها.
الجانب الفني في النص
البحر والإيقاع:
القصيدة منسوجة على البحر الكامل، أحد أكثر البحور طاقةً وإيقاعًا، ما منح النصَّ تدفّقًا موسيقيًّا يتناغم مع الانفعال العاطفي المتوتر. تفعيلتُه الرئيسة متَفاعلن سمحت بامتداد النفي وتكراره، بحيث يصبح الإيقاع نفسه شاهدًا على اضطراب العاشق.
القافية:
التزم الشاعر قافيةً رنّانةً على الألف والراء (جرى – تعثّرا – أبحرا)، وهي قافية طويلة تخلق صدى داخليًّا يوحي بالامتداد، وتعمّق أثر الترديد الذي يتلاءم مع فكرة النفي المستمر.
التكرار:
جاء تكرارُ عبارة «وأنا الذي» ثلاث مرات، ليجعل الأنا محورَ التجربة، ويؤكد حضور الشاعر بوصفه ذاتًا متأرجحةً بين الاعتراف والإنكار. غير أنّ هذا التكرار كاد أن يميل إلى الرتابة لولا تنويع الصور التي صاحبته.
أما عبارة «لا ليس حبًّا» فقد كرّرها ثلاث مرات في مطلع القصيدة وختامها، فيما يُسمّى «البناء الدائري» أو «التذييل»، حيث استعاد المطلعَ في الخاتمة ليؤكد المعنى، كما أوردها في وسط قصيدته لتشكّل ترابطًا عضويًّا غنيًّا.
الصور الشعرية:
تراوحت الصور الشعرية في القصيدة بين:
صور موروثة تقليدية: مثل «بحر العيون» و«الدمع»، وهي امتداد للغزل العربي القديم.
صور مبتكرة: كقوله «وأقام في غمّازةٍ وتسمّرا»، حيث تتحوّل الغمازة إلى موطن إقامة، مما يشي بالانشداه والذوبان. وهذه صورة مبتكرة أبدعها الشاعر بذكاء.
صور بطولية: مثل قوله:
«فغدوت كالمغوار ينحر خيله / حتى يقيم على ضفافك أشهرًا»
حيث تتجسّد علاقة الحب كمعركة فروسية. هنا نلحظ انزياحًا بلاغيًّا: الغمازة تتحول إلى مكان إقامة، والتسمّر فعل يوحي بالدهشة والانشداه، فيما تتحول الحبيبة إلى ساحة نزال.
الصورة البطولية
في مقطع «فغدوت كالمغوار ينحر خيله / حتى يقيم على ضفافك أشهرًا»، ينتقل الشاعر من رومانسية العيون إلى حلبة القتال. توظيف صورة الفارس/المغوار يربط الحب بالبطولة، وكأن الحبيبة هي أرض المعركة والنصر.
إذن، النص يزاوج بين الجسد الفردي (الغمازة، الخال) والمعركة الرمزية (الحرب، القلاع)، ليقول إن الحبَّ ساحةُ مواجهة.
مقارنة مع الغزل العذري
عند جميل أو قيس: الحب عاطفة صافية، تترفع عن الجسد وتتماهى مع الروح.
عند النبراوي هنا: الحب جسدي–بطولي، فيه حضورٌ حسي واضح (الغمازة، الخال) مع استعارة الحرب.
بالتالي، النص أقرب إلى الغزل الحسي–البطولي منه إلى الغزل العذري الروحاني.
المستوى البلاغي والرمزي
تنوّعت المفردات بين الرقة (طفل، غمّازة، ثغر) والصخب القتالي (مغوار، طبول حرب، قلاع). هذه الازدواجية أسست للجانب الدرامي للنص، إذ يتحول الحب إلى صراع داخلي بين الاستسلام والقتال.
الخاتمة
نجح النبراوي في توظيف مفارقة النفي والإثبات لإنتاج قصيدةٍ دراميةٍ تقوم على شدٍّ وجذبٍ داخلي. وقد أسعفه البحرُ الكامل بإيقاعه الواسع، وأغنى النصَّ بتوليفٍ بين الصور الموروثة والمبتكرة، وبين الرقة والبطولة. وعلى الرغم من ميل بعض التكرار إلى الرتابة، فإن النص يظل متماسكًا من الناحية الفنية، ويقدّم تجربة غزلية ذات طابع خاص، تجعل من الإنكار اعترافًا، ومن النفي إثباتًا شعريًّا بليغًا.
د.مي خالد بكليزي
لا ليس حبًّا والذي خـــــلقَ الــورى كـلُّ الحكاية ما أراهُ ولا يُــــــــــرى
كلُّ الحكايةِ إن مررتِ بـــــخاطري سلّمتُ ثــمّ ركبتُ دمعًا قد جــــــرى
وبـــــدوتُ طفلًا أورثتْهُ بغنجِـــــها بينَ الحــروفِ تلعثمًا وتـــــــــــعثّرا
بحرُ العيونِ أتــــوهُ فيهِ تشوّقًـــــــا وأنــا الذي رغمَ العواصفِ أبـــحرا
من رافقَ الدمعاتِ نحو خـــدودِها وأقــامَ في غمّازةٍ وتـــــــــــــــسمّرا
وأنا الذي مذ سالَ خــطُّ طـــــريقِه للــخالِ في وجناتِها وتبـــــــــــعثرا
وأنا الذي مذْ ابتسمتْ تـــــجوبُنــي ذكـــراكِ تعرضُ لي بثغرِك سكّرا
فغدوتُ كالمغوارِ ينــــــحرُ خيلَــهُ حتّــى يقيمَ على ضــــــفافِك أشهرَا
لك عَبرةٌ علِقتْ بهُدبٍ خـــــــاطفٍ هي قطرةٌ أحتاجُها كـــي أبـــــصرا
لا ليس حبًّا بل شجارُ خــــــوافــقٍ كطبولِ حربٍ صوتُها مـــلأ الذُرى
جلساتُنا همساتُنا ومـــــحـــــــــابرٌ خطّتْ علــى أدراجِنــــــــا لتذكّرا
كي لا تموتَ على الرفوفِ روايةٌ نــحنُ الشخوصُ ـلـمن أرادَ تفــكّرا
فأنا وأنتِ وليس غيرُك مـــا أرى وجــمالُهُنّ إذا سطعتِ تبخـــــــــّرا
وبهمسةٍ من ثــغرِك العنبــــيِّ لا أبـــقي قلاعًا للأباةِ ولا ثـــــــــرى
لا ليس حبّــًا فالمحبّةُ قــــــــطرةٌ في بـــحرِ مـــا لقيَ الغلامُ وسطّرا
درامية الإنكار: المواربة بين النفي والإثبات في قصيدة حسن النبراوي
قصيدةُ حسن النبراوي تقوم على لعبةٍ بلاغيةٍ دقيقة، حيثُ يبني الشاعرُ تجربتَه على مفارقةِ النفي والإثبات. فهو يفتتح النصَّ بإنكارِ الحبِّ لفظًا، لكنه يغرق فيه معنىً وصورةً حتى أخمصَ قدميه، فيتحقق بذلك سرُّ المقولة: في النفي إثبات.
إذن، القصيدة قائمة على النفي المتكرر لمسألة الحبّ، وفي ذلك مفارقةٌ جاذبةٌ للقارئ، تنبني عليها أركانُ القصيدة التي تدلّ كل كلمةٍ فيها على حبٍّ عالقٍ أنّى له الامّحاء. هذه المفارقة تمنح النصَّ طابعًا دراميًّا؛ لأن القارئ يُدرك أن النفي مجرّد ستارٍ للبوح. وهذا الأسلوب موجود عند العذريين مثل جميل بن معمر حين يقول:
«خَليلَيَّ إن قالت بُثينةُ ما لهُ ... ألا قد أَرى إلا بُثينةَ للقلبِ»
حيث تُظهر هذه الأبيات محاولةَ الشاعرِ إنكارَ تعلّق قلبه ببثينة أمام أصدقائه، رغم أن قلبه ما زال متعلّقًا بها.
الجانب الفني في النص
البحر والإيقاع:
القصيدة منسوجة على البحر الكامل، أحد أكثر البحور طاقةً وإيقاعًا، ما منح النصَّ تدفّقًا موسيقيًّا يتناغم مع الانفعال العاطفي المتوتر. تفعيلتُه الرئيسة متَفاعلن سمحت بامتداد النفي وتكراره، بحيث يصبح الإيقاع نفسه شاهدًا على اضطراب العاشق.
القافية:
التزم الشاعر قافيةً رنّانةً على الألف والراء (جرى – تعثّرا – أبحرا)، وهي قافية طويلة تخلق صدى داخليًّا يوحي بالامتداد، وتعمّق أثر الترديد الذي يتلاءم مع فكرة النفي المستمر.
التكرار:
جاء تكرارُ عبارة «وأنا الذي» ثلاث مرات، ليجعل الأنا محورَ التجربة، ويؤكد حضور الشاعر بوصفه ذاتًا متأرجحةً بين الاعتراف والإنكار. غير أنّ هذا التكرار كاد أن يميل إلى الرتابة لولا تنويع الصور التي صاحبته.
أما عبارة «لا ليس حبًّا» فقد كرّرها ثلاث مرات في مطلع القصيدة وختامها، فيما يُسمّى «البناء الدائري» أو «التذييل»، حيث استعاد المطلعَ في الخاتمة ليؤكد المعنى، كما أوردها في وسط قصيدته لتشكّل ترابطًا عضويًّا غنيًّا.
الصور الشعرية:
تراوحت الصور الشعرية في القصيدة بين:
صور موروثة تقليدية: مثل «بحر العيون» و«الدمع»، وهي امتداد للغزل العربي القديم.
صور مبتكرة: كقوله «وأقام في غمّازةٍ وتسمّرا»، حيث تتحوّل الغمازة إلى موطن إقامة، مما يشي بالانشداه والذوبان. وهذه صورة مبتكرة أبدعها الشاعر بذكاء.
صور بطولية: مثل قوله:
«فغدوت كالمغوار ينحر خيله / حتى يقيم على ضفافك أشهرًا»
حيث تتجسّد علاقة الحب كمعركة فروسية. هنا نلحظ انزياحًا بلاغيًّا: الغمازة تتحول إلى مكان إقامة، والتسمّر فعل يوحي بالدهشة والانشداه، فيما تتحول الحبيبة إلى ساحة نزال.
الصورة البطولية
في مقطع «فغدوت كالمغوار ينحر خيله / حتى يقيم على ضفافك أشهرًا»، ينتقل الشاعر من رومانسية العيون إلى حلبة القتال. توظيف صورة الفارس/المغوار يربط الحب بالبطولة، وكأن الحبيبة هي أرض المعركة والنصر.
إذن، النص يزاوج بين الجسد الفردي (الغمازة، الخال) والمعركة الرمزية (الحرب، القلاع)، ليقول إن الحبَّ ساحةُ مواجهة.
مقارنة مع الغزل العذري
عند جميل أو قيس: الحب عاطفة صافية، تترفع عن الجسد وتتماهى مع الروح.
عند النبراوي هنا: الحب جسدي–بطولي، فيه حضورٌ حسي واضح (الغمازة، الخال) مع استعارة الحرب.
بالتالي، النص أقرب إلى الغزل الحسي–البطولي منه إلى الغزل العذري الروحاني.
المستوى البلاغي والرمزي
تنوّعت المفردات بين الرقة (طفل، غمّازة، ثغر) والصخب القتالي (مغوار، طبول حرب، قلاع). هذه الازدواجية أسست للجانب الدرامي للنص، إذ يتحول الحب إلى صراع داخلي بين الاستسلام والقتال.
الخاتمة
نجح النبراوي في توظيف مفارقة النفي والإثبات لإنتاج قصيدةٍ دراميةٍ تقوم على شدٍّ وجذبٍ داخلي. وقد أسعفه البحرُ الكامل بإيقاعه الواسع، وأغنى النصَّ بتوليفٍ بين الصور الموروثة والمبتكرة، وبين الرقة والبطولة. وعلى الرغم من ميل بعض التكرار إلى الرتابة، فإن النص يظل متماسكًا من الناحية الفنية، ويقدّم تجربة غزلية ذات طابع خاص، تجعل من الإنكار اعترافًا، ومن النفي إثباتًا شعريًّا بليغًا.
د.مي خالد بكليزي
عدد المشاهدات : (14979)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
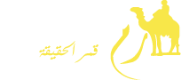
 الرد على تعليق
الرد على تعليق 