لا يوجد تعليقات
"أطباء" مزيفون .. !
رم - في عصر المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، لم يعد الجمهور بحاجة إلى شهادة جامعية أو ترخيص رسمي ليقدم أحدهم نصيحة طبية أو تعليمية أو قانونية. يكفي هاتف ذكي ومتابعون كثر، ليظهر "خبير" جديد يتحدث بثقة عن الصحة والتغذية والعلاج والتعليم، ليغدو الخطر الأكبر الذي بدأ ينتشر بلا تحفظ أكثر من أي وقت مضى.
ففي الوقت الذي يقضي فيه الطبيب قبل أن يصبح طبيبا سنوات طوال ليصبح مؤهلا للتعامل مع صحة الإنسان، تنتشر على منصات التواصل مقاطع يقدمها أشخاص بلا معرفة أو تخصص، يقدّمون "نصائح علاجية" ووصفات مجهولة المصدر، ليتلقفها الملايين من البسطاء على أنها حقائق طبية.
لكن الأمل في مواجهة هذه الظاهرة يظل في الوعي الجمعي النقدي، حين يدرك الجمهور أن الحرية في النشر لا تعني المساواة في المعرفة، وأن حماية الفضاء الرقمي من التضليل الصحي ليست تقييدا للرأي، بل دفاع عن الحق في المعلومة الصحيحة، كما يؤكد متخصصون آراءهم حول ظاهرة الباحثين عن الشعبويات والكسب غير المشروع عبر إنشاء محتوى رقمي على المنصات خاصة في بعض التخصصات الدقيقة والحساسة مثل الطب، مشيرين الى مصطلح "الوباء المعلوماتي" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، والذي ينتشر بأسرع من انتشار الفيروس نفسه.
تقول أستاذة الإعلام في الجامعة العراقية الدكتورة حنان البحراني إن المحتوى الزائف على المنصات الرقمية أصبح ظاهرة مرعبة، وتشير دراسات إلى أن "مقابل كل منشور علمي حقيقي، هناك عشرات المنشورات الزائفة"، وغالباً ما يتداول الناس نصائح طبية أو غذائية تفتقر لأي أساس علمي.
وتضيف أن "كثيراً من المؤثرين يروّجون منتجات للتنحيف أو البشرة أو علاج الأمراض المزمنة دون إشراف طبي، ما يؤدي إلى آثار صحية خطيرة، في ظل غياب رقابة فعلية على هذا النوع من المحتوى".
استاذة الإعلام في الجامعة العراقية الدكتورة حنان البحراني قالت إن خطر المحتوى الزائف أصبح كبيرا جدا حيث تشير بعض الدراسات إلى أن مقابل كل شخص ينشر محتوى حقيقي هناك أكثر من 50 شخصا ينشر محتوى زائفا وكاذبا على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة الى أن تداول الحديث في المجالات الطبية والصحية تحت مسميات مثل المحتوى الصحي أو النصائح الطبية أصبح ظاهرة مرعبة بكل معنى الكلمة وضحاياها كثيرون.
حين يسعى بعض صناع المحتوى وراء الشهرة أو مجاراة الترند أو التكسب المادي على حساب صحة الناس، تكون النتيجة شيوع عادات خاطئة وممارسات غير صحية بين المتلقين، ما يسهم في انتشار الخرافات الطبية والتضليل على نطاق واسع في مسألة تمس الصحة العامة للمجتمع، خاصة في أوقات الأزمات الصحية، تقول الدكتورة البحراني.
وبينت أن هناك إعلانات ينشرها مشتركون على منصات التواصل الاجتماعي ولديهم متابعون كثيرون عن منتجات العناية بالبشرة أو التنحيف أو علاج الأمراض المزمنة والمشاكل الجلدية ليس لها سند قانوني أو رسمي أو صحي يجيز تداولها وبالتالي فإن الآثار الجانبية قد تكون مدمرة.
وأشارت البحراني الى غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المسؤولة على مثل هذا المحتوى في غالبية دول العالم، ومتابعة الناشرين والتحقق من مصادر منتجاتهم، لافتة الى تفشي ظاهرة الأدوية المقلدة وغير الأصلية التي تباع بأسعار منخفضة، ما يسهم في التأثير سلبا على الأدوية الأصلية ذات الجودة العالية والموثوقة.
وأكدت أنها وجدت من خلال متابعتها وجود صفحات تعمل على خلط المواد الكيميائية وتباع باسم (خلطات الأعشاب) علنا دون اي محاسبة قانونية، لكن هناك متخصصين في المجال الطبي يعملون على تفنيد الخرافات وينشؤون محتوى ناقدا يبذلون جهدا في زيادة الوعي ونشره وهذا ما يجعل الوعي عاملا اساسيا في محاصرة الظاهرة.
الباحث الحقوقي ومدير البرامج والأبحاث في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة يؤكد أن من أكثر الظواهر حساسية وخطورة في فضاء الاتصال الرقمي الحديث ظاهرة "الخطاب الزائف حول العلوم" خاصة في الطب والصحة العامة.
وبين أن الحديث غير العلمي عن الطب ظاهرة اتصالية عالمية معروفة، تدرسها اليوم علوم الاتصال باسم "فوضى المعلومات"، وتتخذ أشكالا متعددة؛ المعلومات الخاطئة عندما ينشر محتوى غير دقيق دون نية مسبقة في التضليل، والمعلومات المضللة عندما ينشر محتوى زائف بقصد التأثير أو التربح أو الشهرة، والمعلومات الضارة عندما تستخدم معلومات صحيحة في سياق مغلوط لإحداث أثر سلبي.
وأشار الصرايرة الى دراسات عديدة مستندة الى عمليات رصد أفادت بأن الأخبار الكاذبة خاصة الطبية تنتشر على المنصات الرقمية بسرعة تفوق الأخبار الصحيحة بستة أضعاف، لأن المحتوى الزائف غالبا ما يكون أكثر "إثارة" ودرامية، ومن هنا يمكن القول إن الحديث غير العلمي عن الطب لم يعد مجرد سلوك فردي، بل نمط تواصلي واسع النطاق تدعمه خوارزميات المنصات نفسها التي تكافئ المحتوى الذي يثير الفضول والانفعال أكثر مما تكافئ الدقة العلمية.
وقال، إن الخطر هنا يتجاوز الجانب المعرفي إلى أبعاد اجتماعية وصحية ونفسية وأمنية، مثل تآكل الثقة بالعلم والمؤسسات الطبية، فعندما يتكرر الخطاب الزائف دون تصحيح منهجي، تتراجع الثقة بالخبراء والأطباء، وينظر إلى "التجربة الشخصية" على أنها بديل للعلم، وهذا يقوض ما يسميه المتخصص الألماني بعلم الاجتماع يورجين هابرماس، بـ "العقلانية التواصلية أي الحوار القائم على المعرفة لا الانفعال".
وأوضح أن الجمهور خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تبنى معلومات طبية خاطئة حول اللقاحات أو العلاجات البديلة والذي يؤدي إلى نتائج قاتلة، وأطلقت منظمة الصحة العالمية على هذه الظاهرة مصطلح "الوباء المعلوماتي"، والذي ينتشر بأسرع من انتشار الفيروس نفسه.
وبين أن الحكومات تواجه صعوبة في تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة حين يتأثر الرأي العام بخطاب غير علمي، فتتحول القرارات الصحية إلى رهينة المزاج الرقمي بدلا من الخبرة العلمية،مشيرا الى أن بعض "المؤثرين الطبيين" يروجون لمنتجات أو مواقف تحت غطاء صحي، ما يخلق اقتصادا زائفا مبنيا على الثقة المغلوطة.
وبين أنه حين يهيمن الخطاب غير المتخصص، تفقد المجتمعات قدرتها على التمييز بين الحقيقة العلمية والرأي الشخصي، فيحدث ما يسمى بـ "تسطيح الوعي العام بالعلم"، لافتا الى أن أحد جذور المشكلة أن الجمهور يربط المصداقية بعدد المتابعين لا بالمؤهل العلمي، لذا، يجب إعادة بناء الوعي بأن الخبرة لا تقاس بالشعبية، وأن "المؤثر ليس بالضرورة خبيرا".
ودعا المؤسسات الأكاديمية والنقابات الطبية الى تشجيع العلماء والأطباء على التواصل المباشر مع الجمهور بلغة مبسطة وإنسانية، فغياب الخبراء عن المنصات يفسح المجال لملء الفراغ بالخطاب غير الموثوق، والتواصل العلمي الفعال هو نوع من "المقاومة الناعمة" للمعلومات المضللة، داعيا الى تطوير آليات تصنيف المحتوى الطبي والتحقق منه داخل المنصات نفسها، مثل وضع إشارات توثيق علمي أو روابط لمصادر موثوقة كما بدأت بعض المنصات مثل إكس - تويتر ويوتيوب في تجارب محدودة وهذا ينسجم مع مفهوم العدالة الخوارزمية الذي يدعو إلى جعل الخوارزميات أكثر مسؤولية اجتماعيا.
وأكد الصرايرة أن الخطاب الزائف ينتشر بالعاطفة، فإن الرد العلمي يجب أن يقدم بالعقل والعاطفة معا، فليس كافيا أن نقول "هذا غير صحيح"، بل يجب أن نروي القصة بطريقة جذابة تشعر الجمهور أن العلم أقرب لحياته من الخرافة، وأن الحديث غير العلمي في الطب هو أحد أعراض التحول الاتصالي العميق الذي يجعل المعرفة سلعة اجتماعية لا علمية، فما دام الخوارزم يكافئ "الإثارة" لا "التحقق"، سيبقى الخطاب الزائف أكثر انتشارا من الحقيقة.
وبين أن الأمل قائم في الوعي الجمعي النقدي، حين يدرك الجمهور أن الحرية في النشر لا تعني المساواة في المعرفة، وأن حماية الفضاء الرقمي من التضليل الصحي ليست تقييدا للرأي، بل دفاع عن الحق في المعلومة الصحيحة.
الصحفية ومراسلة تلفزيون فلسطين نادين الشاعر، تشير الى أن جولة واحدة من تصفح منصات التواصل الاجتماعي، وبالتحديد تلك التي تعتمد بالدرجة الاولى على الصور والفيديوهات، سنكتشف خلالها العديد من المواضيع الطبية باستخدام معلومات غير علمية ودون مصادر موثوقة او معروفة على الأقل، لكنها تعرض بأسلوب شيق او بسيط للفهم او ملفت جدا للانتباه لأي مستخدم عادي وبالتالي تنتج تفاعلا تختلف درجاته وطبيعته.
وترى الشاعر أن نشر هذه المعلومات غير الحقيقية او الصحيحة وتداولها وكأنها معلومات مسلم بها، يؤدي إلى توقع نتائج غير مرضية، او كارثية، او حتى عواقب تعود بالسوء على المستخدم الذي اعتمد المعلومة بشكلها المقدم.
وأكدت أن هذه العواقب تختلف بالفعل بحسب المعلومات غير العلمية المنشورة، فمنها ما يدعي محاربة السرطان، وإيجاد الحل السحري لبعض الأمراض المزمنة، او استخدام مواد طبيعية بصورتها الخام على الجسم او البشرة او غيرها ما يؤدي بالفعل الى نتائج تفاقم الحالة الأولية.
ولفتت إلى أن من الضروري جدا ان يكون هناك بالفعل رقابة على مثل هذه المنشورات، خاصة تلك التي تنشر من قبل صفحات غير مختصة او غير موثوقة وليس لها أي أوراق اعتماد للحديث في مواضيع علمية وطبية.
وقالت الباحثة والأستاذة الجامعية بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار في تونس الدكتورة حنان المليتي، إن الحديث غير العلمي عن موضوعات علمية من قبل غير المختصين ظاهرة مثيرة للقلق على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت، إن هذا الحكم لا يعتمد على الملاحظة العينية فحسب، بل تؤكده أيضا تقارير ودراسات عدة، على سبيل المثال، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى ما أسمته "انفوفيديميك" أو "وباء المعلومات" خلال جائحة كوفيد-19، والذي تمثل في فيض من المعلومات المغلوطة والضارة.
وأشارت إلى أن دراسة نشرت في "دورية الجمعية الطبية الأميريكية" كشفت عن ارتفاع ملحوظ بنسبة المحتوى الطبي غير الدقيق والمضلل على منصات مثل "يوتيوب" و "إنستغرام"، مقدمة من قبل ما يعرف بـ "المؤثرين" من غير ذوي الاختصاص، مثل "الانستغرامور" و"التيكتوكور".. وهذا كله قد يجعل من وصف هذه الممارسة بـ "الظاهرة" أمرا مقبولا يعكس واقع الحال.
وأشارت المليتي إلى أنه على المستوى المجتمعي والوطني، فإن تفشي هذه الظاهرة يولد اتجاها خطيرا يتمثل بـ "استسهال أو استساغة استشارة غير المختص"، حيث يعزف الأفراد عن استشارة الأطباء والمعالجين المختصين، مستبدلين إياهم بآراء غير المؤهلين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقويض الثقة بالمنظومة الطبية والعلمية الرسمية، واللجوء إلى بدائل وهمية، وتعميم الفوضى المعلوماتية، حيث تختلط الحقائق العلمية بالأوهام، ما يصعب على الفرد التمييز بينها، وإلحاق الضرر بالصحة العامة، كما في حالات نشر الشكوك حول اللقاحات، ما يعرقل جهود مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، وبالتالي، فإن الآثار ليست محصورة في الجانب الذاتي للفرد، بل تمتد إلى البنية الموضوعية والصحة العامة في الدولة.
وقالت، إن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تبني استراتيجية شاملة ومتكاملة، تعمل على عدة مستويات بشكل متواز على المستوى التنظيمي والقانوني وهنا دور الدولة والجهات الرقابية حيث أن من الضروري تدخل سلطات الإشراف والرقابة بتطبيق أطر قانونية واضحة تحظر ممارسة النشاط الطبي أو تقديم الاستشارات الطبية من قبل غير المؤهلين والمعتمدين على المنصات الرقمية كما في الواقع، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، والتعاون مع إدارات المنصات لتقييد أو حظر الحسابات التي تنشر مضامين طبية مضللة.
ودعت الملّيتي النقابات والمؤسسات الطبية الى تعزيز وجودها الرقمي الفاعل، من خلال إنشاء منصات رسمية وقنوات اتصال مباشر مع الجمهور، لتقديم المعلومة الطبية الدقيقة بلغة مبسطة، وتكليف مختصين بمهمة المراقبة والتصدي للمعلومات الخاطئة، عبر إنشاء "أركان للتثبت من الحقائق" (Fact-Checking)، ونشر التصحيحات بشكل استباقي، لا سيما في أوقات الأزمات الصحية.
من جهته أشار المدرس المساعد في جامعة الأهرام الكندية المصرية محمد أشرف الى أن الحديث غير العلمي عن الموضوعات الطبية والتعليمية والقانونية ظاهرة واضحة وملحوظة على منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، أتاح الانفتاح الإعلامي وحرية النشر عبر المنصات الرقمية لأي مستخدم إمكانية إنتاج وتداول محتوى دون ضوابط مهنية أو علمية صارمة، ما أدى إلى انتشار كم كبير من المعلومات الطبية غير الدقيقة أو المضللة.
وأضاف أشرف، إن الحديث غير الموثوق عن القضايا العلمية والقانونية والغذائية بخاصة تلك المرتبطة بالطب والصحة العامة، خطرا حقيقيا على المجتمع لما يترتب عليه من آثار معرفية وسلوكية وصحية بالغة الخطورة، فعندما تنتشر المعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تؤدي إلى تضليل المتلقين وتشويش وعيهم العلمي، ما يجعلهم أكثر عرضة لتصديق الإشاعات واتباع ممارسات صحية غير آمنة.
وبين أنه يمكن تنفيذ مجموعة من الحملات التوعوية المتكاملة لزيادة وعي الجمهور بخطورة الحديث غير العلمي عن القضايا الطبية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تضافر جهود المؤسسات الإعلامية والتعليمية والصحية.
ففي الوقت الذي يقضي فيه الطبيب قبل أن يصبح طبيبا سنوات طوال ليصبح مؤهلا للتعامل مع صحة الإنسان، تنتشر على منصات التواصل مقاطع يقدمها أشخاص بلا معرفة أو تخصص، يقدّمون "نصائح علاجية" ووصفات مجهولة المصدر، ليتلقفها الملايين من البسطاء على أنها حقائق طبية.
لكن الأمل في مواجهة هذه الظاهرة يظل في الوعي الجمعي النقدي، حين يدرك الجمهور أن الحرية في النشر لا تعني المساواة في المعرفة، وأن حماية الفضاء الرقمي من التضليل الصحي ليست تقييدا للرأي، بل دفاع عن الحق في المعلومة الصحيحة، كما يؤكد متخصصون آراءهم حول ظاهرة الباحثين عن الشعبويات والكسب غير المشروع عبر إنشاء محتوى رقمي على المنصات خاصة في بعض التخصصات الدقيقة والحساسة مثل الطب، مشيرين الى مصطلح "الوباء المعلوماتي" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، والذي ينتشر بأسرع من انتشار الفيروس نفسه.
تقول أستاذة الإعلام في الجامعة العراقية الدكتورة حنان البحراني إن المحتوى الزائف على المنصات الرقمية أصبح ظاهرة مرعبة، وتشير دراسات إلى أن "مقابل كل منشور علمي حقيقي، هناك عشرات المنشورات الزائفة"، وغالباً ما يتداول الناس نصائح طبية أو غذائية تفتقر لأي أساس علمي.
وتضيف أن "كثيراً من المؤثرين يروّجون منتجات للتنحيف أو البشرة أو علاج الأمراض المزمنة دون إشراف طبي، ما يؤدي إلى آثار صحية خطيرة، في ظل غياب رقابة فعلية على هذا النوع من المحتوى".
استاذة الإعلام في الجامعة العراقية الدكتورة حنان البحراني قالت إن خطر المحتوى الزائف أصبح كبيرا جدا حيث تشير بعض الدراسات إلى أن مقابل كل شخص ينشر محتوى حقيقي هناك أكثر من 50 شخصا ينشر محتوى زائفا وكاذبا على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة الى أن تداول الحديث في المجالات الطبية والصحية تحت مسميات مثل المحتوى الصحي أو النصائح الطبية أصبح ظاهرة مرعبة بكل معنى الكلمة وضحاياها كثيرون.
حين يسعى بعض صناع المحتوى وراء الشهرة أو مجاراة الترند أو التكسب المادي على حساب صحة الناس، تكون النتيجة شيوع عادات خاطئة وممارسات غير صحية بين المتلقين، ما يسهم في انتشار الخرافات الطبية والتضليل على نطاق واسع في مسألة تمس الصحة العامة للمجتمع، خاصة في أوقات الأزمات الصحية، تقول الدكتورة البحراني.
وبينت أن هناك إعلانات ينشرها مشتركون على منصات التواصل الاجتماعي ولديهم متابعون كثيرون عن منتجات العناية بالبشرة أو التنحيف أو علاج الأمراض المزمنة والمشاكل الجلدية ليس لها سند قانوني أو رسمي أو صحي يجيز تداولها وبالتالي فإن الآثار الجانبية قد تكون مدمرة.
وأشارت البحراني الى غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المسؤولة على مثل هذا المحتوى في غالبية دول العالم، ومتابعة الناشرين والتحقق من مصادر منتجاتهم، لافتة الى تفشي ظاهرة الأدوية المقلدة وغير الأصلية التي تباع بأسعار منخفضة، ما يسهم في التأثير سلبا على الأدوية الأصلية ذات الجودة العالية والموثوقة.
وأكدت أنها وجدت من خلال متابعتها وجود صفحات تعمل على خلط المواد الكيميائية وتباع باسم (خلطات الأعشاب) علنا دون اي محاسبة قانونية، لكن هناك متخصصين في المجال الطبي يعملون على تفنيد الخرافات وينشؤون محتوى ناقدا يبذلون جهدا في زيادة الوعي ونشره وهذا ما يجعل الوعي عاملا اساسيا في محاصرة الظاهرة.
الباحث الحقوقي ومدير البرامج والأبحاث في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة يؤكد أن من أكثر الظواهر حساسية وخطورة في فضاء الاتصال الرقمي الحديث ظاهرة "الخطاب الزائف حول العلوم" خاصة في الطب والصحة العامة.
وبين أن الحديث غير العلمي عن الطب ظاهرة اتصالية عالمية معروفة، تدرسها اليوم علوم الاتصال باسم "فوضى المعلومات"، وتتخذ أشكالا متعددة؛ المعلومات الخاطئة عندما ينشر محتوى غير دقيق دون نية مسبقة في التضليل، والمعلومات المضللة عندما ينشر محتوى زائف بقصد التأثير أو التربح أو الشهرة، والمعلومات الضارة عندما تستخدم معلومات صحيحة في سياق مغلوط لإحداث أثر سلبي.
وأشار الصرايرة الى دراسات عديدة مستندة الى عمليات رصد أفادت بأن الأخبار الكاذبة خاصة الطبية تنتشر على المنصات الرقمية بسرعة تفوق الأخبار الصحيحة بستة أضعاف، لأن المحتوى الزائف غالبا ما يكون أكثر "إثارة" ودرامية، ومن هنا يمكن القول إن الحديث غير العلمي عن الطب لم يعد مجرد سلوك فردي، بل نمط تواصلي واسع النطاق تدعمه خوارزميات المنصات نفسها التي تكافئ المحتوى الذي يثير الفضول والانفعال أكثر مما تكافئ الدقة العلمية.
وقال، إن الخطر هنا يتجاوز الجانب المعرفي إلى أبعاد اجتماعية وصحية ونفسية وأمنية، مثل تآكل الثقة بالعلم والمؤسسات الطبية، فعندما يتكرر الخطاب الزائف دون تصحيح منهجي، تتراجع الثقة بالخبراء والأطباء، وينظر إلى "التجربة الشخصية" على أنها بديل للعلم، وهذا يقوض ما يسميه المتخصص الألماني بعلم الاجتماع يورجين هابرماس، بـ "العقلانية التواصلية أي الحوار القائم على المعرفة لا الانفعال".
وأوضح أن الجمهور خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تبنى معلومات طبية خاطئة حول اللقاحات أو العلاجات البديلة والذي يؤدي إلى نتائج قاتلة، وأطلقت منظمة الصحة العالمية على هذه الظاهرة مصطلح "الوباء المعلوماتي"، والذي ينتشر بأسرع من انتشار الفيروس نفسه.
وبين أن الحكومات تواجه صعوبة في تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة حين يتأثر الرأي العام بخطاب غير علمي، فتتحول القرارات الصحية إلى رهينة المزاج الرقمي بدلا من الخبرة العلمية،مشيرا الى أن بعض "المؤثرين الطبيين" يروجون لمنتجات أو مواقف تحت غطاء صحي، ما يخلق اقتصادا زائفا مبنيا على الثقة المغلوطة.
وبين أنه حين يهيمن الخطاب غير المتخصص، تفقد المجتمعات قدرتها على التمييز بين الحقيقة العلمية والرأي الشخصي، فيحدث ما يسمى بـ "تسطيح الوعي العام بالعلم"، لافتا الى أن أحد جذور المشكلة أن الجمهور يربط المصداقية بعدد المتابعين لا بالمؤهل العلمي، لذا، يجب إعادة بناء الوعي بأن الخبرة لا تقاس بالشعبية، وأن "المؤثر ليس بالضرورة خبيرا".
ودعا المؤسسات الأكاديمية والنقابات الطبية الى تشجيع العلماء والأطباء على التواصل المباشر مع الجمهور بلغة مبسطة وإنسانية، فغياب الخبراء عن المنصات يفسح المجال لملء الفراغ بالخطاب غير الموثوق، والتواصل العلمي الفعال هو نوع من "المقاومة الناعمة" للمعلومات المضللة، داعيا الى تطوير آليات تصنيف المحتوى الطبي والتحقق منه داخل المنصات نفسها، مثل وضع إشارات توثيق علمي أو روابط لمصادر موثوقة كما بدأت بعض المنصات مثل إكس - تويتر ويوتيوب في تجارب محدودة وهذا ينسجم مع مفهوم العدالة الخوارزمية الذي يدعو إلى جعل الخوارزميات أكثر مسؤولية اجتماعيا.
وأكد الصرايرة أن الخطاب الزائف ينتشر بالعاطفة، فإن الرد العلمي يجب أن يقدم بالعقل والعاطفة معا، فليس كافيا أن نقول "هذا غير صحيح"، بل يجب أن نروي القصة بطريقة جذابة تشعر الجمهور أن العلم أقرب لحياته من الخرافة، وأن الحديث غير العلمي في الطب هو أحد أعراض التحول الاتصالي العميق الذي يجعل المعرفة سلعة اجتماعية لا علمية، فما دام الخوارزم يكافئ "الإثارة" لا "التحقق"، سيبقى الخطاب الزائف أكثر انتشارا من الحقيقة.
وبين أن الأمل قائم في الوعي الجمعي النقدي، حين يدرك الجمهور أن الحرية في النشر لا تعني المساواة في المعرفة، وأن حماية الفضاء الرقمي من التضليل الصحي ليست تقييدا للرأي، بل دفاع عن الحق في المعلومة الصحيحة.
الصحفية ومراسلة تلفزيون فلسطين نادين الشاعر، تشير الى أن جولة واحدة من تصفح منصات التواصل الاجتماعي، وبالتحديد تلك التي تعتمد بالدرجة الاولى على الصور والفيديوهات، سنكتشف خلالها العديد من المواضيع الطبية باستخدام معلومات غير علمية ودون مصادر موثوقة او معروفة على الأقل، لكنها تعرض بأسلوب شيق او بسيط للفهم او ملفت جدا للانتباه لأي مستخدم عادي وبالتالي تنتج تفاعلا تختلف درجاته وطبيعته.
وترى الشاعر أن نشر هذه المعلومات غير الحقيقية او الصحيحة وتداولها وكأنها معلومات مسلم بها، يؤدي إلى توقع نتائج غير مرضية، او كارثية، او حتى عواقب تعود بالسوء على المستخدم الذي اعتمد المعلومة بشكلها المقدم.
وأكدت أن هذه العواقب تختلف بالفعل بحسب المعلومات غير العلمية المنشورة، فمنها ما يدعي محاربة السرطان، وإيجاد الحل السحري لبعض الأمراض المزمنة، او استخدام مواد طبيعية بصورتها الخام على الجسم او البشرة او غيرها ما يؤدي بالفعل الى نتائج تفاقم الحالة الأولية.
ولفتت إلى أن من الضروري جدا ان يكون هناك بالفعل رقابة على مثل هذه المنشورات، خاصة تلك التي تنشر من قبل صفحات غير مختصة او غير موثوقة وليس لها أي أوراق اعتماد للحديث في مواضيع علمية وطبية.
وقالت الباحثة والأستاذة الجامعية بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار في تونس الدكتورة حنان المليتي، إن الحديث غير العلمي عن موضوعات علمية من قبل غير المختصين ظاهرة مثيرة للقلق على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت، إن هذا الحكم لا يعتمد على الملاحظة العينية فحسب، بل تؤكده أيضا تقارير ودراسات عدة، على سبيل المثال، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى ما أسمته "انفوفيديميك" أو "وباء المعلومات" خلال جائحة كوفيد-19، والذي تمثل في فيض من المعلومات المغلوطة والضارة.
وأشارت إلى أن دراسة نشرت في "دورية الجمعية الطبية الأميريكية" كشفت عن ارتفاع ملحوظ بنسبة المحتوى الطبي غير الدقيق والمضلل على منصات مثل "يوتيوب" و "إنستغرام"، مقدمة من قبل ما يعرف بـ "المؤثرين" من غير ذوي الاختصاص، مثل "الانستغرامور" و"التيكتوكور".. وهذا كله قد يجعل من وصف هذه الممارسة بـ "الظاهرة" أمرا مقبولا يعكس واقع الحال.
وأشارت المليتي إلى أنه على المستوى المجتمعي والوطني، فإن تفشي هذه الظاهرة يولد اتجاها خطيرا يتمثل بـ "استسهال أو استساغة استشارة غير المختص"، حيث يعزف الأفراد عن استشارة الأطباء والمعالجين المختصين، مستبدلين إياهم بآراء غير المؤهلين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقويض الثقة بالمنظومة الطبية والعلمية الرسمية، واللجوء إلى بدائل وهمية، وتعميم الفوضى المعلوماتية، حيث تختلط الحقائق العلمية بالأوهام، ما يصعب على الفرد التمييز بينها، وإلحاق الضرر بالصحة العامة، كما في حالات نشر الشكوك حول اللقاحات، ما يعرقل جهود مكافحة الأمراض والسيطرة عليها، وبالتالي، فإن الآثار ليست محصورة في الجانب الذاتي للفرد، بل تمتد إلى البنية الموضوعية والصحة العامة في الدولة.
وقالت، إن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تبني استراتيجية شاملة ومتكاملة، تعمل على عدة مستويات بشكل متواز على المستوى التنظيمي والقانوني وهنا دور الدولة والجهات الرقابية حيث أن من الضروري تدخل سلطات الإشراف والرقابة بتطبيق أطر قانونية واضحة تحظر ممارسة النشاط الطبي أو تقديم الاستشارات الطبية من قبل غير المؤهلين والمعتمدين على المنصات الرقمية كما في الواقع، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، والتعاون مع إدارات المنصات لتقييد أو حظر الحسابات التي تنشر مضامين طبية مضللة.
ودعت الملّيتي النقابات والمؤسسات الطبية الى تعزيز وجودها الرقمي الفاعل، من خلال إنشاء منصات رسمية وقنوات اتصال مباشر مع الجمهور، لتقديم المعلومة الطبية الدقيقة بلغة مبسطة، وتكليف مختصين بمهمة المراقبة والتصدي للمعلومات الخاطئة، عبر إنشاء "أركان للتثبت من الحقائق" (Fact-Checking)، ونشر التصحيحات بشكل استباقي، لا سيما في أوقات الأزمات الصحية.
من جهته أشار المدرس المساعد في جامعة الأهرام الكندية المصرية محمد أشرف الى أن الحديث غير العلمي عن الموضوعات الطبية والتعليمية والقانونية ظاهرة واضحة وملحوظة على منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، أتاح الانفتاح الإعلامي وحرية النشر عبر المنصات الرقمية لأي مستخدم إمكانية إنتاج وتداول محتوى دون ضوابط مهنية أو علمية صارمة، ما أدى إلى انتشار كم كبير من المعلومات الطبية غير الدقيقة أو المضللة.
وأضاف أشرف، إن الحديث غير الموثوق عن القضايا العلمية والقانونية والغذائية بخاصة تلك المرتبطة بالطب والصحة العامة، خطرا حقيقيا على المجتمع لما يترتب عليه من آثار معرفية وسلوكية وصحية بالغة الخطورة، فعندما تنتشر المعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تؤدي إلى تضليل المتلقين وتشويش وعيهم العلمي، ما يجعلهم أكثر عرضة لتصديق الإشاعات واتباع ممارسات صحية غير آمنة.
وبين أنه يمكن تنفيذ مجموعة من الحملات التوعوية المتكاملة لزيادة وعي الجمهور بخطورة الحديث غير العلمي عن القضايا الطبية على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تضافر جهود المؤسسات الإعلامية والتعليمية والصحية.
عدد المشاهدات : (10443)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
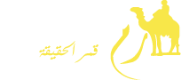
 الرد على تعليق
الرد على تعليق