لا يوجد تعليقات
(رحلات في بلاد النوبة (سنة 1813م)
رم - د. أحمد عويدي العبادي (أبو البشر) والطبيب د. نمي
(رحلات في بلاد النوبة (سنة 1813م) هذا هو الكتاب الرابع الذي أقدمه إلى القارئ العربي من مؤلفات الرحالة السويسري–الإنجليزي جون لويس بوركهارت (Johann Ludwig Burckhardt)، أحد أعظم المستكشفين الذين جابوا أرجاء المشرق العربي والإسلامي في مطلع القرن التاسع عشر، وسجّلوا بعيون يقظة وأقلام دقيقة تفاصيل البيئة، والمجتمع، والسلطة، والتاريخ. سبق أن ترجمت له "ملاحظات عن البدو والوهابيين"، و*"رحلات في سوريا والبلاد المقدسة"، و"رحلة في جزيرة العرب"*، وها هو بين أيدينا اليوم عمله الرابع في هذا السياق: "رحلات في النوبة".
وبهذه السلسلة يكتمل للقارئ العربي واحد من أهم المشروعات الاستكشافية التي امتدت بين 1810–1817م، أي سبع سنوات متصلة قضاها بوركهارت بين القبائل والبوادي والقرى، متقمصًا زيّ العرب ولسانهم، متوغلاً في تفاصيلهم، عاكسًا صورة صادقة لما رآه وما عاشه.
لكن تقديم هذا الكتاب لا يعني مجرد إضافة ترجمة جديدة إلى مكتبة الرحلات العربية. فبالنسبة لي، وقد بلغت هذه اللحظة التي أضع فيها أمام القارئ ثمرة سنوات طويلة من البحث والترجمة، فإن الأمر يتجاوز حدود النقل من لغة إلى أخرى. إنها شهادة حياة ومعرفة، ومشروع ثقافي يضاف إلى ما أنجزته عبر العقود الماضية، إذ إنني بترجمتي لهذا الكتاب أكون قد أكملت ترجمة ما يزيد على ثلاثين كتابًا من الإنجليزية إلى العربية، فضلًا عن مؤلفاتي الأصلية التي تعالج قضايا التاريخ والفكر والسياسة والاجتماع في الأردن والعالم العربي. إنها حصيلة جهد متواصل، ووفاء لرؤية آمنت بها منذ شبابي: أن نعيد الاعتبار لتراثنا وهويتنا وذاكرتنا، عبر حوار حيّ مع النصوص التي كتبها الآخرون عنا أو بجوارنا.
بوركهارت – عين أوروبية في قلب الشرق
كان بوركهارت من القلة القادرين على تجاوز حدود النظرة الاستشراقية التقليدية. لم يكتفِ أن يزور المدن والأسواق كضيف عابر، بل عاش بين العرب والنوبيين، لبس ثيابهم، وتكلم لغتهم بلهجاتها المحلية، وحضر مجالسهم، وأكل من طعامهم، وسلك مسالك القوافل والحجاج. ومن هنا جاءت كتاباته مشبعة بالحياة، بعيدة عن المبالغة والتزييف. فهو لم يكن يستعلي على من يصفهم، ولم يكن يكتب ليشبع فضولًا سياحيًا، بل ليقدّم صورة أقرب إلى الواقع، بقدر ما تسمح به أدوات عصره.
إن أهمية بوركهارت بالنسبة لنا نحن العرب تكمن في كونه شاهدًا خارجيًا، لكن شهادته لا تخلو من الصدق. لقد رصد عاداتنا اليومية، أسواقنا، قبائلنا، نظمنا السياسية الهشة، وحياتنا في تداخلها مع النيل والصحراء والبحر. وإذا كنا اليوم نقرأ هذه الصفحات، فإننا نقرأ فيها ذواتنا من خلال عيون الآخر، وهو أمر له خطورته وقيمته في آن واحد: خطورته لأنه يعكس أحيانًا رؤية أوروبية محمّلة بالمقارنات، وقيمته لأنه يوثّق تفاصيل لم يكن أبناؤها في الغالب يدوّنونها.
النوبة – جغرافيا الإنسان والصبر
في هذا الكتاب، يقدّم بوركهارت وصفًا للنوبة ليس فقط كأرض جغرافية تمتد على ضفاف النيل والبحر الأحمر، بل كمسرح إنساني يعيش فيه أناس صاغتهم الطبيعة وصاغوا هم بدورهم بيئتهم. الفلاح النوبي مرتبط بفيضانات النيل، يزرع ويحصُد وفق قوانينه، بينما البدوي البشاري أو الهدندوة يعيش في صحراء لا ترحم، يقيس حياته بالغارات ومواسم الكلأ. في السوق تلتقي هذه العوالم مع التجار الهنود واليمنيين، ومع الحجاج القادمين من المغرب ومصر ووسط إفريقيا.
إنها صورة مكثفة عن التداخل الحضاري، وعن قدرة الإنسان على التكيف. ورحلة بوركهارت في النوبة لم تكن مجرد انتقال من قرية إلى أخرى، بل كانت قراءة في كتاب الطبيعة والإنسان معًا: كيف تصوغ البيئة طباع الناس، وكيف يواجه الناس الطبيعة بقوانينهم وأعرافهم، وكيف تتشكل السياسة في ظل غياب الدولة المركزية.
أمانة علمية ودقة في النقل
لقد عُرف بوركهارت بدقته وحرصه على التوثيق. لا يطلق حكمًا إلا إذا دعمه بالمشاهدة المباشرة، ولا يصف حادثة إلا بعد أن يتحقق منها بالسؤال والمقارنة. وهذه الروح العلمية هي ما جعلت كتبه تظلّ مراجع حتى اليوم، رغم مرور أكثر من قرنين على كتابتها. وربما كانت هذه الأمانة العلمية هي ما شدّني إلى ترجمته منذ البداية، فوجدت أن في نصوصه مادة يمكن أن تُقرأ لا للتسلية، بل كوثيقة للتاريخ.
مشروعي في الترجمة والتأليف
وأنا أقدّم هذا الكتاب، أجد لزامًا عليّ أن أربطه بمسيرتي العلمية والعملية. لقد كرّست سنوات طويلة في ترجمة ثلاثين كتابًا من الإنجليزية إلى العربية، إلى جانب تأليف عشرات المؤلفات في التاريخ والفكر والسياسة والاجتماع. وما زلت أؤمن أن هذا الجهد ليس ترفًا فكريًا، بل هو رسالة حضارية: أن نقرأ تراثنا بأدواتنا، وأن نفهم كيف نظر الآخرون إلينا، وأن نصنع لأنفسنا ذاكرة مكتوبة تحفظ للأجيال القادمة صورة دقيقة عن ماضيها.
فإذا كان بوركهارت قد جاب بلادنا من 1810 إلى 1817 وسجّلها بقلمه، فإننا اليوم نعيد قراءة نصوصه بلغة الضاد، نضيف إليها وعينا، ونضعها في سياقنا الثقافي والوطني. وهذه الترجمة ليست مجرد «نقل» من الإنجليزية، بل هي تحقيقٌ وإعادة صياغة معرفية، تجعل النص أكثر قربًا من القارئ العربي، وأكثر انغراسًا في سياقنا الحضاري.
تجربتي مع بوركهارت والترجمة
حين شرعت لأول مرة في التعامل مع نصوص بوركهارت قبل عقود، لم أكن أتعامل معها بوصفها نصوصًا أوروبية تتحدث عن الشرق، بل بوصفها شهادة خارجية على واقعنا العربي والإسلامي في لحظة تاريخية دقيقة. كان هاجسي الأساسي هو: كيف نعيد هذه النصوص إلينا نحن العرب بلغتنا، وكيف نقرأها بعيوننا، لا بعيون الغرب فقط؟
واجهتني في البداية صعوبات جمّة؛ فبوركهارت كتب بلغة إنجليزية القرن التاسع عشر، محمّلة بالتراكيب الكلاسيكية، والمصطلحات الجغرافية والإثنوغرافية التي لم يكن لها دائمًا ما يقابلها بدقة في العربية. كان عليّ أن أوازن بين أمانة النقل الحرفي، وبين روح النص التي يجب أن تبقى حيّة في الترجمة. وكنت أحيانًا أستغرق ساعات طويلة في البحث عن كلمة واحدة، حتى أعثر على المقابل العربي الذي يحمل معناها الكامل، أو أضع شرحًا يوضح مدلولها.
لكن الأصعب من اللغة كان مواجهة الخلفية الفكرية التي تحكمت في كتابة الرحلة. فبوركهارت – مهما حاول أن يكون محايدًا – كان ابن بيئته الأوروبية، يحمل في ذهنه صورًا ومقارنات قد تظلم الواقع الشرقي أو تختزله. هنا كان دور المترجم والباحث: أن يضع النص في سياقه، وأن ينوّه إلى ما فيه من تحيّز أو قصور، دون أن يسقط قيمته العلمية.
وبينما كنت أنجز ترجماتي الثلاثة السابقة لبوركهارت، شعرت أنني أفتح نافذة على عالم عربي منسي، وأنني أُعيد إلى لغتنا مشاهدات دوّنتها يد غريبة، لكنها صادقة في كثير من تفاصيلها. أما في هذا الكتاب، "رحلات في بلاد النوبة"، فقد شعرت أن المهمة أكثر إلحاحًا، لأن النوبة ظلت دومًا على هامش الدراسات العربية، رغم أنها كانت قلبًا نابضًا في التاريخ الإفريقي–العربي.
العلاقة بين نصوص بوركهارت ومشروعي الفكري
لم تكن هذه الترجمات معزولة عن مشروعي الفكري والبحثي، بل كانت جزءًا منه. فمنذ أن بدأت مسيرتي العلمية في جامعة كامبريدج، كان همّي الأكبر أن أُبرز الهوية الوطنية العربية الأردنية بوصفها امتدادًا لحضارات عريقة، لا نتاجًا عرضيًا للقرن العشرين. وقد سعيت إلى قراءة تاريخ الأردن والمنطقة من منظور حضاري واجتماعي يدمج بين النصوص الغربية والذاكرة المحلية، بين الوثيقة والشفاهة، بين التاريخ المكتوب والتاريخ الحيّ في العشائر والأرض.
نصوص بوركهارت تخدم هذا المشروع من زاويتين:
أنها تقدّم صورة خارجية عمّا كان عليه المجتمع العربي والإسلامي في بدايات القرن التاسع عشر، أي قبل أن تتمكن القوى الاستعمارية من فرض سيطرتها الكاملة على المنطقة.
أنها تكشف عن العمق التاريخي والجغرافي للأرض التي نسميها اليوم الأردن وفلسطين ومصر والسودان، وتربطها بسياق أوسع يمتد إلى الجزيرة العربية وإفريقيا.
ومن خلال ترجمتي لهذه النصوص، لم أكن أطمح فقط إلى إثراء المكتبة العربية بأدب الرحلة، بل إلى تسليح القارئ العربي بأداة لفهم كيف نظر الآخرون إلينا، وكيف كنا نحن في لحظة فارقة من تاريخنا. وهذا الفهم ضروري لكل من يريد أن يعيد بناء الهوية على أسس صلبة، لا على صور مشوّهة أو منقوصة.
بوركهارت والهوية الأردنية
قد يتساءل القارئ: وما علاقة "رحلات في بلاد النوبة" بمشروع الهوية الأردنية؟ الجواب أن فهم النوبة – بما هي معبر حضاري وجغرافي – يساعدنا على فهم موقع الأردن في شبكة العلاقات الإقليمية. فكما كانت النوبة جسرًا بين إفريقيا ومصر والحجاز، كان الأردن ولا يزال جسرًا بين الشام والجزيرة ومصر. كلاهما عاش في قلب طرق التجارة والحج والغزو، وكلاهما تشكّل من تداخل القبائل والزراعة والبداوة.
من هنا، فإن قراءة بوركهارت للنوبة تفتح أمامنا مرآة لفهم الأردن، لا بالتشابه فقط، بل أيضًا بالمقارنة والاختلاف. والأهم من ذلك، أنها تذكّرنا بأن الهويات الوطنية لا تُبنى في عزلة، بل في صميم التداخل الحضاري. وهذا هو جوهر مشروعي: أن نعيد قراءة الأردن والعرب في ضوء هذا التداخل، وأن نكشف عن استمرارية الجذور عبر آلاف السنين.
الواقع العربي ودروس الرحلة
حين أقرأ اليوم نصوص بوركهارت، لا أراها فقط وثائق تاريخية، بل أجد فيها إشارات حية لواقعنا العربي المعاصر. ففي وصفه لغارات القبائل وغياب الدولة المركزية، أرى صورة لما يحدث في بعض بلداننا حين تنهار السلطة ويصبح السلاح هو الحكم. وفي وصفه للنيل كمصدر للحياة والموت، أرى صورة معاصرة لصراعاتنا حول الموارد الطبيعية والمياه. وفي حديثه عن الأسواق التي تجمع العرب والهنود والأفارقة، أرى ملامح العولمة قبل أن تُصاغ كمفهوم حديث.
إن الدرس الأعمق من هذه الرحلة هو أن المجتمع العربي – رغم فقره أحيانًا وهشاشة سلطته – ظل قادرًا على الصمود والتكيّف. وهذا ما ينبغي أن نستحضره اليوم ونحن نواجه تحديات داخلية وخارجية. فالتاريخ ليس مجرد ماضٍ منسي، بل مدرسة حية نتعلم منها كيف نبقى، وكيف نبني مستقبلًا أكثر ثباتًا وعدلًا.
معنى الترجمة في مشروع حضاري
إن ترجمتي لهذا الكتاب، ولما يزيد على ثلاثين كتابًا آخر، ليست جهدًا فرديًا معزولًا، بل هي جزء من قناعتي العميقة بأن الترجمة فعل مقاومة حضارية. فنحن حين نترجم، لا ننقل الكلمات فقط، بل نستعيد الذاكرة، ونفكك الصور التي رسمها الآخرون عنا، ونضعها بين أيدينا لنقرأها بوعينا نحن.
ولذلك، فإنني لا أقدّم هذه الترجمات كأعمال علمية باردة، بل كمشروعات ثقافية حية، تتصل بتاريخنا وهويتنا ونضالنا من أجل أن نكتب أنفسنا بأقلامنا. وإن كان بوركهارت قد عاش بين العرب سبع سنوات وكتب ما كتب، فإن واجبنا نحن أن نعيد قراءة نصوصه من موقع الفاعل لا المفعول به، من موقع الشريك لا المتفرج.
كلمة أخيرة إلى القارئ
أيها القارئ العزيز، بين يديك اليوم نصٌّ ليس ملكي، ولا ملك بوركهارت وحده، بل هو جزء من ذاكرتنا الجماعية. إنني إذ أقدّمه مترجمًا، أضعه في مساره الصحيح: نصًّا عربيًا مكتوبًا بلغتنا، قادرًا أن يخاطب وعينا الوطني والقومي. وأدعوك أن تقرأه لا كحكاية بعيدة، بل كمرآة تعكس شيئًا من حاضرنا، ودليلًا إلى ما يمكن أن يكون مستقبلنا.
بهذه الترجمة، أضيف لبنة جديدة إلى مشروعي في الترجمة والتأليف، وأرجو أن تكون خطوة أخرى في سبيل استعادة الوعي، وتثبيت الهوية، وإعادة الاعتبار للتاريخ العربي والإسلامي بوصفه تاريخًا حيًّا ما زال يسكن وجداننا ويشكّل حاضرنا.
إنني إذ أهدي هذا الكتاب إلى القارئ العربي، أراه لبنة جديدة في مشروع أكبر: مشروع استعادة الذات عبر الكلمة. فالنوبة التي وصفها بوركهارت لم تعد هي نفسها، لكن دروسها باقية: صبر الإنسان، أثر النيل، قوانين الطبيعة، هشاشة السلطة، والتداخل الحضاري. وهذه الدروس ليست حكرًا على الماضي، بل هي مفاتيح لفهم حاضرنا ومستقبلنا.
أرجو أن يجد القارئ في هذه الترجمة نافذة لفهم التاريخ والجغرافيا والإنسان، وأن تكون حافزًا لمزيد من البحث والتأمل، وأن تظلّ كلمات بوركهارت – وقد جرى بعثها بالعربية – شاهدًا على أن المعرفة جسر بين العصور، وأن الترجمة فعل مقاومة ضد النسيان.
(رحلات في بلاد النوبة (سنة 1813م) هذا هو الكتاب الرابع الذي أقدمه إلى القارئ العربي من مؤلفات الرحالة السويسري–الإنجليزي جون لويس بوركهارت (Johann Ludwig Burckhardt)، أحد أعظم المستكشفين الذين جابوا أرجاء المشرق العربي والإسلامي في مطلع القرن التاسع عشر، وسجّلوا بعيون يقظة وأقلام دقيقة تفاصيل البيئة، والمجتمع، والسلطة، والتاريخ. سبق أن ترجمت له "ملاحظات عن البدو والوهابيين"، و*"رحلات في سوريا والبلاد المقدسة"، و"رحلة في جزيرة العرب"*، وها هو بين أيدينا اليوم عمله الرابع في هذا السياق: "رحلات في النوبة".
وبهذه السلسلة يكتمل للقارئ العربي واحد من أهم المشروعات الاستكشافية التي امتدت بين 1810–1817م، أي سبع سنوات متصلة قضاها بوركهارت بين القبائل والبوادي والقرى، متقمصًا زيّ العرب ولسانهم، متوغلاً في تفاصيلهم، عاكسًا صورة صادقة لما رآه وما عاشه.
لكن تقديم هذا الكتاب لا يعني مجرد إضافة ترجمة جديدة إلى مكتبة الرحلات العربية. فبالنسبة لي، وقد بلغت هذه اللحظة التي أضع فيها أمام القارئ ثمرة سنوات طويلة من البحث والترجمة، فإن الأمر يتجاوز حدود النقل من لغة إلى أخرى. إنها شهادة حياة ومعرفة، ومشروع ثقافي يضاف إلى ما أنجزته عبر العقود الماضية، إذ إنني بترجمتي لهذا الكتاب أكون قد أكملت ترجمة ما يزيد على ثلاثين كتابًا من الإنجليزية إلى العربية، فضلًا عن مؤلفاتي الأصلية التي تعالج قضايا التاريخ والفكر والسياسة والاجتماع في الأردن والعالم العربي. إنها حصيلة جهد متواصل، ووفاء لرؤية آمنت بها منذ شبابي: أن نعيد الاعتبار لتراثنا وهويتنا وذاكرتنا، عبر حوار حيّ مع النصوص التي كتبها الآخرون عنا أو بجوارنا.
بوركهارت – عين أوروبية في قلب الشرق
كان بوركهارت من القلة القادرين على تجاوز حدود النظرة الاستشراقية التقليدية. لم يكتفِ أن يزور المدن والأسواق كضيف عابر، بل عاش بين العرب والنوبيين، لبس ثيابهم، وتكلم لغتهم بلهجاتها المحلية، وحضر مجالسهم، وأكل من طعامهم، وسلك مسالك القوافل والحجاج. ومن هنا جاءت كتاباته مشبعة بالحياة، بعيدة عن المبالغة والتزييف. فهو لم يكن يستعلي على من يصفهم، ولم يكن يكتب ليشبع فضولًا سياحيًا، بل ليقدّم صورة أقرب إلى الواقع، بقدر ما تسمح به أدوات عصره.
إن أهمية بوركهارت بالنسبة لنا نحن العرب تكمن في كونه شاهدًا خارجيًا، لكن شهادته لا تخلو من الصدق. لقد رصد عاداتنا اليومية، أسواقنا، قبائلنا، نظمنا السياسية الهشة، وحياتنا في تداخلها مع النيل والصحراء والبحر. وإذا كنا اليوم نقرأ هذه الصفحات، فإننا نقرأ فيها ذواتنا من خلال عيون الآخر، وهو أمر له خطورته وقيمته في آن واحد: خطورته لأنه يعكس أحيانًا رؤية أوروبية محمّلة بالمقارنات، وقيمته لأنه يوثّق تفاصيل لم يكن أبناؤها في الغالب يدوّنونها.
النوبة – جغرافيا الإنسان والصبر
في هذا الكتاب، يقدّم بوركهارت وصفًا للنوبة ليس فقط كأرض جغرافية تمتد على ضفاف النيل والبحر الأحمر، بل كمسرح إنساني يعيش فيه أناس صاغتهم الطبيعة وصاغوا هم بدورهم بيئتهم. الفلاح النوبي مرتبط بفيضانات النيل، يزرع ويحصُد وفق قوانينه، بينما البدوي البشاري أو الهدندوة يعيش في صحراء لا ترحم، يقيس حياته بالغارات ومواسم الكلأ. في السوق تلتقي هذه العوالم مع التجار الهنود واليمنيين، ومع الحجاج القادمين من المغرب ومصر ووسط إفريقيا.
إنها صورة مكثفة عن التداخل الحضاري، وعن قدرة الإنسان على التكيف. ورحلة بوركهارت في النوبة لم تكن مجرد انتقال من قرية إلى أخرى، بل كانت قراءة في كتاب الطبيعة والإنسان معًا: كيف تصوغ البيئة طباع الناس، وكيف يواجه الناس الطبيعة بقوانينهم وأعرافهم، وكيف تتشكل السياسة في ظل غياب الدولة المركزية.
أمانة علمية ودقة في النقل
لقد عُرف بوركهارت بدقته وحرصه على التوثيق. لا يطلق حكمًا إلا إذا دعمه بالمشاهدة المباشرة، ولا يصف حادثة إلا بعد أن يتحقق منها بالسؤال والمقارنة. وهذه الروح العلمية هي ما جعلت كتبه تظلّ مراجع حتى اليوم، رغم مرور أكثر من قرنين على كتابتها. وربما كانت هذه الأمانة العلمية هي ما شدّني إلى ترجمته منذ البداية، فوجدت أن في نصوصه مادة يمكن أن تُقرأ لا للتسلية، بل كوثيقة للتاريخ.
مشروعي في الترجمة والتأليف
وأنا أقدّم هذا الكتاب، أجد لزامًا عليّ أن أربطه بمسيرتي العلمية والعملية. لقد كرّست سنوات طويلة في ترجمة ثلاثين كتابًا من الإنجليزية إلى العربية، إلى جانب تأليف عشرات المؤلفات في التاريخ والفكر والسياسة والاجتماع. وما زلت أؤمن أن هذا الجهد ليس ترفًا فكريًا، بل هو رسالة حضارية: أن نقرأ تراثنا بأدواتنا، وأن نفهم كيف نظر الآخرون إلينا، وأن نصنع لأنفسنا ذاكرة مكتوبة تحفظ للأجيال القادمة صورة دقيقة عن ماضيها.
فإذا كان بوركهارت قد جاب بلادنا من 1810 إلى 1817 وسجّلها بقلمه، فإننا اليوم نعيد قراءة نصوصه بلغة الضاد، نضيف إليها وعينا، ونضعها في سياقنا الثقافي والوطني. وهذه الترجمة ليست مجرد «نقل» من الإنجليزية، بل هي تحقيقٌ وإعادة صياغة معرفية، تجعل النص أكثر قربًا من القارئ العربي، وأكثر انغراسًا في سياقنا الحضاري.
تجربتي مع بوركهارت والترجمة
حين شرعت لأول مرة في التعامل مع نصوص بوركهارت قبل عقود، لم أكن أتعامل معها بوصفها نصوصًا أوروبية تتحدث عن الشرق، بل بوصفها شهادة خارجية على واقعنا العربي والإسلامي في لحظة تاريخية دقيقة. كان هاجسي الأساسي هو: كيف نعيد هذه النصوص إلينا نحن العرب بلغتنا، وكيف نقرأها بعيوننا، لا بعيون الغرب فقط؟
واجهتني في البداية صعوبات جمّة؛ فبوركهارت كتب بلغة إنجليزية القرن التاسع عشر، محمّلة بالتراكيب الكلاسيكية، والمصطلحات الجغرافية والإثنوغرافية التي لم يكن لها دائمًا ما يقابلها بدقة في العربية. كان عليّ أن أوازن بين أمانة النقل الحرفي، وبين روح النص التي يجب أن تبقى حيّة في الترجمة. وكنت أحيانًا أستغرق ساعات طويلة في البحث عن كلمة واحدة، حتى أعثر على المقابل العربي الذي يحمل معناها الكامل، أو أضع شرحًا يوضح مدلولها.
لكن الأصعب من اللغة كان مواجهة الخلفية الفكرية التي تحكمت في كتابة الرحلة. فبوركهارت – مهما حاول أن يكون محايدًا – كان ابن بيئته الأوروبية، يحمل في ذهنه صورًا ومقارنات قد تظلم الواقع الشرقي أو تختزله. هنا كان دور المترجم والباحث: أن يضع النص في سياقه، وأن ينوّه إلى ما فيه من تحيّز أو قصور، دون أن يسقط قيمته العلمية.
وبينما كنت أنجز ترجماتي الثلاثة السابقة لبوركهارت، شعرت أنني أفتح نافذة على عالم عربي منسي، وأنني أُعيد إلى لغتنا مشاهدات دوّنتها يد غريبة، لكنها صادقة في كثير من تفاصيلها. أما في هذا الكتاب، "رحلات في بلاد النوبة"، فقد شعرت أن المهمة أكثر إلحاحًا، لأن النوبة ظلت دومًا على هامش الدراسات العربية، رغم أنها كانت قلبًا نابضًا في التاريخ الإفريقي–العربي.
العلاقة بين نصوص بوركهارت ومشروعي الفكري
لم تكن هذه الترجمات معزولة عن مشروعي الفكري والبحثي، بل كانت جزءًا منه. فمنذ أن بدأت مسيرتي العلمية في جامعة كامبريدج، كان همّي الأكبر أن أُبرز الهوية الوطنية العربية الأردنية بوصفها امتدادًا لحضارات عريقة، لا نتاجًا عرضيًا للقرن العشرين. وقد سعيت إلى قراءة تاريخ الأردن والمنطقة من منظور حضاري واجتماعي يدمج بين النصوص الغربية والذاكرة المحلية، بين الوثيقة والشفاهة، بين التاريخ المكتوب والتاريخ الحيّ في العشائر والأرض.
نصوص بوركهارت تخدم هذا المشروع من زاويتين:
أنها تقدّم صورة خارجية عمّا كان عليه المجتمع العربي والإسلامي في بدايات القرن التاسع عشر، أي قبل أن تتمكن القوى الاستعمارية من فرض سيطرتها الكاملة على المنطقة.
أنها تكشف عن العمق التاريخي والجغرافي للأرض التي نسميها اليوم الأردن وفلسطين ومصر والسودان، وتربطها بسياق أوسع يمتد إلى الجزيرة العربية وإفريقيا.
ومن خلال ترجمتي لهذه النصوص، لم أكن أطمح فقط إلى إثراء المكتبة العربية بأدب الرحلة، بل إلى تسليح القارئ العربي بأداة لفهم كيف نظر الآخرون إلينا، وكيف كنا نحن في لحظة فارقة من تاريخنا. وهذا الفهم ضروري لكل من يريد أن يعيد بناء الهوية على أسس صلبة، لا على صور مشوّهة أو منقوصة.
بوركهارت والهوية الأردنية
قد يتساءل القارئ: وما علاقة "رحلات في بلاد النوبة" بمشروع الهوية الأردنية؟ الجواب أن فهم النوبة – بما هي معبر حضاري وجغرافي – يساعدنا على فهم موقع الأردن في شبكة العلاقات الإقليمية. فكما كانت النوبة جسرًا بين إفريقيا ومصر والحجاز، كان الأردن ولا يزال جسرًا بين الشام والجزيرة ومصر. كلاهما عاش في قلب طرق التجارة والحج والغزو، وكلاهما تشكّل من تداخل القبائل والزراعة والبداوة.
من هنا، فإن قراءة بوركهارت للنوبة تفتح أمامنا مرآة لفهم الأردن، لا بالتشابه فقط، بل أيضًا بالمقارنة والاختلاف. والأهم من ذلك، أنها تذكّرنا بأن الهويات الوطنية لا تُبنى في عزلة، بل في صميم التداخل الحضاري. وهذا هو جوهر مشروعي: أن نعيد قراءة الأردن والعرب في ضوء هذا التداخل، وأن نكشف عن استمرارية الجذور عبر آلاف السنين.
الواقع العربي ودروس الرحلة
حين أقرأ اليوم نصوص بوركهارت، لا أراها فقط وثائق تاريخية، بل أجد فيها إشارات حية لواقعنا العربي المعاصر. ففي وصفه لغارات القبائل وغياب الدولة المركزية، أرى صورة لما يحدث في بعض بلداننا حين تنهار السلطة ويصبح السلاح هو الحكم. وفي وصفه للنيل كمصدر للحياة والموت، أرى صورة معاصرة لصراعاتنا حول الموارد الطبيعية والمياه. وفي حديثه عن الأسواق التي تجمع العرب والهنود والأفارقة، أرى ملامح العولمة قبل أن تُصاغ كمفهوم حديث.
إن الدرس الأعمق من هذه الرحلة هو أن المجتمع العربي – رغم فقره أحيانًا وهشاشة سلطته – ظل قادرًا على الصمود والتكيّف. وهذا ما ينبغي أن نستحضره اليوم ونحن نواجه تحديات داخلية وخارجية. فالتاريخ ليس مجرد ماضٍ منسي، بل مدرسة حية نتعلم منها كيف نبقى، وكيف نبني مستقبلًا أكثر ثباتًا وعدلًا.
معنى الترجمة في مشروع حضاري
إن ترجمتي لهذا الكتاب، ولما يزيد على ثلاثين كتابًا آخر، ليست جهدًا فرديًا معزولًا، بل هي جزء من قناعتي العميقة بأن الترجمة فعل مقاومة حضارية. فنحن حين نترجم، لا ننقل الكلمات فقط، بل نستعيد الذاكرة، ونفكك الصور التي رسمها الآخرون عنا، ونضعها بين أيدينا لنقرأها بوعينا نحن.
ولذلك، فإنني لا أقدّم هذه الترجمات كأعمال علمية باردة، بل كمشروعات ثقافية حية، تتصل بتاريخنا وهويتنا ونضالنا من أجل أن نكتب أنفسنا بأقلامنا. وإن كان بوركهارت قد عاش بين العرب سبع سنوات وكتب ما كتب، فإن واجبنا نحن أن نعيد قراءة نصوصه من موقع الفاعل لا المفعول به، من موقع الشريك لا المتفرج.
كلمة أخيرة إلى القارئ
أيها القارئ العزيز، بين يديك اليوم نصٌّ ليس ملكي، ولا ملك بوركهارت وحده، بل هو جزء من ذاكرتنا الجماعية. إنني إذ أقدّمه مترجمًا، أضعه في مساره الصحيح: نصًّا عربيًا مكتوبًا بلغتنا، قادرًا أن يخاطب وعينا الوطني والقومي. وأدعوك أن تقرأه لا كحكاية بعيدة، بل كمرآة تعكس شيئًا من حاضرنا، ودليلًا إلى ما يمكن أن يكون مستقبلنا.
بهذه الترجمة، أضيف لبنة جديدة إلى مشروعي في الترجمة والتأليف، وأرجو أن تكون خطوة أخرى في سبيل استعادة الوعي، وتثبيت الهوية، وإعادة الاعتبار للتاريخ العربي والإسلامي بوصفه تاريخًا حيًّا ما زال يسكن وجداننا ويشكّل حاضرنا.
إنني إذ أهدي هذا الكتاب إلى القارئ العربي، أراه لبنة جديدة في مشروع أكبر: مشروع استعادة الذات عبر الكلمة. فالنوبة التي وصفها بوركهارت لم تعد هي نفسها، لكن دروسها باقية: صبر الإنسان، أثر النيل، قوانين الطبيعة، هشاشة السلطة، والتداخل الحضاري. وهذه الدروس ليست حكرًا على الماضي، بل هي مفاتيح لفهم حاضرنا ومستقبلنا.
أرجو أن يجد القارئ في هذه الترجمة نافذة لفهم التاريخ والجغرافيا والإنسان، وأن تكون حافزًا لمزيد من البحث والتأمل، وأن تظلّ كلمات بوركهارت – وقد جرى بعثها بالعربية – شاهدًا على أن المعرفة جسر بين العصور، وأن الترجمة فعل مقاومة ضد النسيان.
عدد المشاهدات : (4041)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
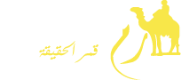
 الرد على تعليق
الرد على تعليق