لا يوجد تعليقات
جيل الشباب في المنطقة: لاعب غائب أم قوة تغيير حتمية؟
رم - الدكتور ليث عبدالله القهيوي
بين وعود الإصلاح وتحديات الواقع، يقف جيل الشباب في المنطقة عند مفترق طرق: إما أن يبقى متفرجًا، أو يتحول إلى صانع تغيير لا غنى عنه
في المشهد العربي الواسع، يحضر الشباب في كل التفاصيل اليومية ويغيبون عن نتائجها الكبرى. تراهم في الجامعات والمنصات الرقمية والمبادرات التطوعية، لكن أثرهم يتبدد عند أبواب سوق العمل وصناعة القرار. في الأردن تتكثف هذه المفارقة: جيل واسع التعليم والطموح، سريع التعلّم والتكيّف، يقف أمام اقتصاد يتوسع ببطء، وبيروقراطية تُطيل الطريق، وتمثيل سياسي لم يترجم بعد إلى وزنٍ مؤثر داخل المؤسسات.
السؤال ليس من هم الشباب، بل لماذا لا تتحول طاقتهم المتراكمة إلى نفوذٍ عام يقود التغيير؟
المقاربة المهنية تقتضي البدء من “المحرّك” لا من “المشهد” ، المحرك هنا هو الطلب على العمل المنتج ، حين تتباطأ قدرة الاقتصاد على خلق وظائف لائقة، تصبح بوابة الدخول إلى الحياة المهنية أضيق من أن تستوعب دفعات الخريجين سنويًا، وتتفاقم المشكلة حين تميل بنية السوق إلى الخدمات منخفضة القيمة المضافة، فيترنّح الشباب بين وظائف مؤقتة أو غير منظمة وأجورٍ محدودة، فيما يؤجلون خطط الاستقلال وتأسيس الأسرة، وعلى الضفة الأخرى، يخرج العرض من الجامعات والمعاهد بمهاراتٍ نظرية غزيرة وتجربة عملية متواضعة، معضلة “الوظيفة الأولى” تتحول إلى حلقة مفرغة: لا خبرة بلا وظيفة، ولا وظيفة بلا خبرة.
داخل هذا الشد والجذب يقيم عامل ثالث غالبًا ما يجري التقليل من شأنه: البيئة المؤسسية والاجتماعية، فترخيص شركة ناشئة يستنزف وقتًا وموارد قبل أن ترى النور، والنقل العام يتحسن على محاور رئيسية، لكنه لا يحل دائمًا عقدة “المسافة الأخيرة” بين محطةٍ وفرصة، والجغرافيا تُفرّق ما جمعته التكنولوجيا: فرصٌ متركزة في مناطق محددة، وهوامش سكنية بعيدة عنها، عند النساء الشابات، تتضاعف القيود: كلفة رعاية الأطفال، أمن التنقل، ثقافة عمل لا تزال تتعلم معنى المرونة، وحين تزداد كلفة المعيشة، تتآكل شهية المخاطرة ويعلو القلق النفسي، فيتراجع الميل إلى المبادرة والابتكار.
مع ذلك، ليست القصة سوداوية، فهنالك روافع حقيقية ظهرت خلال السنوات الأخيرة، المنظومة الريادية اكتسبت خبرة وتجربة، وفتحت التكنولوجيا أبوابًا للعمل الحر وللتوظيف عن بُعد، الجامعات بدأت تقترب أكثر من القطاع الخاص، ومراكز الشباب تتوسع في التدريب والمشاريع المجتمعية، الأهم أن لدى جيل اليوم استعدادًا عمليًا: يقيس نجاحه بما يُنجز لا بما يعلن ، شباب اليوم لا يسألون عن الشعارات، بل عن الفرصة الملموسة: وظيفة، عقد، أو دعم يفتح باب السوق لكنه يحتاج إلى عمل مضاعف مؤسسي يحوّل النشاط إلى نتيجة، والدعم إلى عقد، والتدريب إلى وظيفة.
المطلوب مقاربة عملية واضحة في صياغتها، صلبة في مضمونها ، أولًا، إدارة برامج المهارات بمنطق النتيجة لا بمنطق النشاط، فلا قيمة لدورةٍ تدريبية ما لم تُفضِ إلى تعيينٍ فعلي أو زيادة أجر ملموسة ، وصيغة العقود القائمة على الأداء تمنح الجميع معيارًا واحدًا: كم شابًا وشابة انتقلوا إلى عملٍ مستدام، وكم شركة ناشئة باعت خدمةً حقيقية لا عرضًا تجريبيًا.
ثانيًا، تحويل جزء واضح من المشتريات العامة إلى رافعة للسوق المحلي الشاب، فحين تشتري المؤسسات خدماتٍ رقمية وإبداعية من شركات يقودها شباب، يصبح التمويل المبكر جسراً إلى السوق لا جائزة رمزية عابرة.
ثالثًا، ترميم فجوة التعليم والسوق من الداخل: مشاريع تخرج مرتبطة بجهات حقيقية، تدريب داخل مواقع العمل بمعايير جودة، أساتذة زائرون من الصناعة، واعتماد أكاديمي يشترط روابط سوقية لا شهاداتٍ فقط.
في السياسة، لا تكفي القوانين المعلنة ما لم تستكمل بسلم واضح لصعود القيادات الشابة، التجربة تُبنى طبقة فوق طبقة: اتحادات طلاب تنجب كوادر بلدية، وهؤلاء يصعدون إلى أحزاب تقدم لهم مواقع متقدمة ومسؤولية حقيقية، من دون تنظيم حزبي جاد داخل الجامعات والمجتمعات المحلية، ستبقى المشاركة موسمية والإحباط متجدّدًا، وعلى مستوى الحياة اليومية، يجب أن تترجم وعود المرونة إلى بنود عقود: دوام جزئي أو هجين، عمل عن بُعد بضمانات. حين تصبح حياة العمل ممكنة، تصبح المشاركة الاقتصادية ممكنة، ويستعيد الاقتصاد نصف طاقته المهدرة.
السنوات المقبلة مفتوحة على ثلاثة احتمالات، في الأول، وهو الأكثر واقعية إذا أحسنا التنفيذ، يجري ضبط البوصلة على مؤشرات قابلة للقياس: تراجع تدريجي لبطالة الشباب، اتساع مشاركة النساء، تحسّن الوصول الجغرافي إلى الفرص، فيتحقق ذلك حين تُربط كل مبادرة بميزان أثر واضح، ويُعلن التقدم للرأي العام بانتظام. في الاحتمال الثاني، يستمر “العمل كالمعتاد”: برامج كثيرة بلا خريطة طريق، ونتائج تتقدم ببطء لا يغير المزاج العام، هنا سيبقى الشباب في موقع المتفرّج، ويستمر نزيف الوقت والثقة. أما الاحتمال الثالث، فيبدأ إذا تزامنت صدمات خارجية مع تردد داخلي، فتتجمد الوظائف وترتفع نوايا الهجرة وتضعف الشراكة بين الأجيال.
الخلاصة المهنية بسيطة بقدر ما هي حاسمة: الشباب الأردني ليس لاعبًا غائبًا، لكنه لم يُمنح بعد موقعه الطبيعي في الملعب ، المقعد محفوظ لمن يربط السياسات بالنتائج، ويحوّل الدعم إلى عقود، ويختصر المسافات بين محطةٍ وفرصة، ويمنح النساء الشابات شروطًا عادلة للانخراط، عندها فقط ينتقل السؤال من “هل الشباب قوة تغيير؟” إلى أي تغيير سيقوده الشباب ، ومن سيُحاسب على تحقيقه؟”، الإجابة ليست في الشعارات، بل في الأرقام التي تُعلن، والوظائف التي تُستحدث، والثقة التي تعود إلى مكانها الطبيعي: بين جيل يريد أن يصنع مستقبله، ودولة ترى فيه شريكًا لا جمهورًا.
بين وعود الإصلاح وتحديات الواقع، يقف جيل الشباب في المنطقة عند مفترق طرق: إما أن يبقى متفرجًا، أو يتحول إلى صانع تغيير لا غنى عنه
في المشهد العربي الواسع، يحضر الشباب في كل التفاصيل اليومية ويغيبون عن نتائجها الكبرى. تراهم في الجامعات والمنصات الرقمية والمبادرات التطوعية، لكن أثرهم يتبدد عند أبواب سوق العمل وصناعة القرار. في الأردن تتكثف هذه المفارقة: جيل واسع التعليم والطموح، سريع التعلّم والتكيّف، يقف أمام اقتصاد يتوسع ببطء، وبيروقراطية تُطيل الطريق، وتمثيل سياسي لم يترجم بعد إلى وزنٍ مؤثر داخل المؤسسات.
السؤال ليس من هم الشباب، بل لماذا لا تتحول طاقتهم المتراكمة إلى نفوذٍ عام يقود التغيير؟
المقاربة المهنية تقتضي البدء من “المحرّك” لا من “المشهد” ، المحرك هنا هو الطلب على العمل المنتج ، حين تتباطأ قدرة الاقتصاد على خلق وظائف لائقة، تصبح بوابة الدخول إلى الحياة المهنية أضيق من أن تستوعب دفعات الخريجين سنويًا، وتتفاقم المشكلة حين تميل بنية السوق إلى الخدمات منخفضة القيمة المضافة، فيترنّح الشباب بين وظائف مؤقتة أو غير منظمة وأجورٍ محدودة، فيما يؤجلون خطط الاستقلال وتأسيس الأسرة، وعلى الضفة الأخرى، يخرج العرض من الجامعات والمعاهد بمهاراتٍ نظرية غزيرة وتجربة عملية متواضعة، معضلة “الوظيفة الأولى” تتحول إلى حلقة مفرغة: لا خبرة بلا وظيفة، ولا وظيفة بلا خبرة.
داخل هذا الشد والجذب يقيم عامل ثالث غالبًا ما يجري التقليل من شأنه: البيئة المؤسسية والاجتماعية، فترخيص شركة ناشئة يستنزف وقتًا وموارد قبل أن ترى النور، والنقل العام يتحسن على محاور رئيسية، لكنه لا يحل دائمًا عقدة “المسافة الأخيرة” بين محطةٍ وفرصة، والجغرافيا تُفرّق ما جمعته التكنولوجيا: فرصٌ متركزة في مناطق محددة، وهوامش سكنية بعيدة عنها، عند النساء الشابات، تتضاعف القيود: كلفة رعاية الأطفال، أمن التنقل، ثقافة عمل لا تزال تتعلم معنى المرونة، وحين تزداد كلفة المعيشة، تتآكل شهية المخاطرة ويعلو القلق النفسي، فيتراجع الميل إلى المبادرة والابتكار.
مع ذلك، ليست القصة سوداوية، فهنالك روافع حقيقية ظهرت خلال السنوات الأخيرة، المنظومة الريادية اكتسبت خبرة وتجربة، وفتحت التكنولوجيا أبوابًا للعمل الحر وللتوظيف عن بُعد، الجامعات بدأت تقترب أكثر من القطاع الخاص، ومراكز الشباب تتوسع في التدريب والمشاريع المجتمعية، الأهم أن لدى جيل اليوم استعدادًا عمليًا: يقيس نجاحه بما يُنجز لا بما يعلن ، شباب اليوم لا يسألون عن الشعارات، بل عن الفرصة الملموسة: وظيفة، عقد، أو دعم يفتح باب السوق لكنه يحتاج إلى عمل مضاعف مؤسسي يحوّل النشاط إلى نتيجة، والدعم إلى عقد، والتدريب إلى وظيفة.
المطلوب مقاربة عملية واضحة في صياغتها، صلبة في مضمونها ، أولًا، إدارة برامج المهارات بمنطق النتيجة لا بمنطق النشاط، فلا قيمة لدورةٍ تدريبية ما لم تُفضِ إلى تعيينٍ فعلي أو زيادة أجر ملموسة ، وصيغة العقود القائمة على الأداء تمنح الجميع معيارًا واحدًا: كم شابًا وشابة انتقلوا إلى عملٍ مستدام، وكم شركة ناشئة باعت خدمةً حقيقية لا عرضًا تجريبيًا.
ثانيًا، تحويل جزء واضح من المشتريات العامة إلى رافعة للسوق المحلي الشاب، فحين تشتري المؤسسات خدماتٍ رقمية وإبداعية من شركات يقودها شباب، يصبح التمويل المبكر جسراً إلى السوق لا جائزة رمزية عابرة.
ثالثًا، ترميم فجوة التعليم والسوق من الداخل: مشاريع تخرج مرتبطة بجهات حقيقية، تدريب داخل مواقع العمل بمعايير جودة، أساتذة زائرون من الصناعة، واعتماد أكاديمي يشترط روابط سوقية لا شهاداتٍ فقط.
في السياسة، لا تكفي القوانين المعلنة ما لم تستكمل بسلم واضح لصعود القيادات الشابة، التجربة تُبنى طبقة فوق طبقة: اتحادات طلاب تنجب كوادر بلدية، وهؤلاء يصعدون إلى أحزاب تقدم لهم مواقع متقدمة ومسؤولية حقيقية، من دون تنظيم حزبي جاد داخل الجامعات والمجتمعات المحلية، ستبقى المشاركة موسمية والإحباط متجدّدًا، وعلى مستوى الحياة اليومية، يجب أن تترجم وعود المرونة إلى بنود عقود: دوام جزئي أو هجين، عمل عن بُعد بضمانات. حين تصبح حياة العمل ممكنة، تصبح المشاركة الاقتصادية ممكنة، ويستعيد الاقتصاد نصف طاقته المهدرة.
السنوات المقبلة مفتوحة على ثلاثة احتمالات، في الأول، وهو الأكثر واقعية إذا أحسنا التنفيذ، يجري ضبط البوصلة على مؤشرات قابلة للقياس: تراجع تدريجي لبطالة الشباب، اتساع مشاركة النساء، تحسّن الوصول الجغرافي إلى الفرص، فيتحقق ذلك حين تُربط كل مبادرة بميزان أثر واضح، ويُعلن التقدم للرأي العام بانتظام. في الاحتمال الثاني، يستمر “العمل كالمعتاد”: برامج كثيرة بلا خريطة طريق، ونتائج تتقدم ببطء لا يغير المزاج العام، هنا سيبقى الشباب في موقع المتفرّج، ويستمر نزيف الوقت والثقة. أما الاحتمال الثالث، فيبدأ إذا تزامنت صدمات خارجية مع تردد داخلي، فتتجمد الوظائف وترتفع نوايا الهجرة وتضعف الشراكة بين الأجيال.
الخلاصة المهنية بسيطة بقدر ما هي حاسمة: الشباب الأردني ليس لاعبًا غائبًا، لكنه لم يُمنح بعد موقعه الطبيعي في الملعب ، المقعد محفوظ لمن يربط السياسات بالنتائج، ويحوّل الدعم إلى عقود، ويختصر المسافات بين محطةٍ وفرصة، ويمنح النساء الشابات شروطًا عادلة للانخراط، عندها فقط ينتقل السؤال من “هل الشباب قوة تغيير؟” إلى أي تغيير سيقوده الشباب ، ومن سيُحاسب على تحقيقه؟”، الإجابة ليست في الشعارات، بل في الأرقام التي تُعلن، والوظائف التي تُستحدث، والثقة التي تعود إلى مكانها الطبيعي: بين جيل يريد أن يصنع مستقبله، ودولة ترى فيه شريكًا لا جمهورًا.
عدد المشاهدات : (4140)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
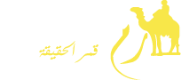
 الرد على تعليق
الرد على تعليق