حجازي يكتب : ضمان الجودة في الجامعات : الطريق الصعب نحو التميز "التحدي السادس "
التعليم العالي في الأردن
واقع وتحديات
(6 – 7)
التحدي السادس: الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة: الطريق الصعب نحو التميز
د. هيثم علي حجازي
يمثّل الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة حجر الزاوية في تطوير التعليم العالي، حيث يُعتبر الضامن الرئيسي لفاعلية البرامج الأكاديمية، وكفاءة التدريس، وتنافسية الخريجين. وفي عصر العولمة والمعايير الدولية، أصبحت مؤسسات التعليم العالي – بما فيها الجامعات الأردنية – مطالبة بمواكبة معايير الجودة العالمية ليس فقط من أجل البقاء، بل من أجل أن تكون فاعلة ومؤثرة في محيطها المحلي والدولي.
ورغم الجهود التي تبذلها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في الأردن، لا تزال العديد من الجامعات الأردنية، الرسمية منها والخاصة، تواجه تحديات حقيقية في الوصول إلى اعتماد أكاديمي مستدام، وفي بناء أنظمة داخلية للجودة تكون فاعلة ومؤثرة وليست شكلية أو بيروقراطية.
فهم الاعتماد الأكاديمي والجودة
الاعتماد الأكاديمي: هو عملية تقييم مؤسسي أو برامجي تهدف إلى التأكد من أن المؤسسة أو البرنامج التعليمي يستوفي الحد الأدنى من المعايير المطلوبة التي تضمن جودة التعليم. وفي الوقت ذاته، فإن ضمان الجودة يشمل مجموعة من العمليات والإجراءات والسياسات التي تنفذها المؤسسات التعليمية لضمان تقديم خدمات تعليمية بمعايير عالية ومستدامة، ويشمل ذلك التدريس، البحث العلمي، الإرشاد الأكاديمي، دعم الطلبة، وقياس المخرجات.
ملامح تحدي الاعتماد والجودة في الجامعات الأردنية
• تفاوت في مستوى الالتزام بمعايير الاعتماد: رغم أن معظم الجامعات الأردنية لديها برامج أكاديمية معتمدة محليًا، إلا أن مستوى الالتزام بالمعايير الجوهرية يختلف، وبعض الجامعات تعتبر الاعتماد هدفًا شكليًا للحصول على الترخيص فقط، وليس عملية تطويرية مستمرة.
• ضعف الأنظمة الداخلية للجودة: تعاني بعض الجامعات من غياب وحدات جودة مؤسسية فعالة، أو من ضعف قدرات فرق الجودة، أو من غياب ثقافة تقييم الأداء والتحسين المستمر بين الكوادر الأكاديمية والإدارية.
• قلة البرامج المعتمدة دوليا: عدد البرامج الحاصلة على اعتماد دولي (مثل ABET، AACSB، FIBAA، وغيرها) لا يزال محدودًا، وهو ما يقلل من القدرة على المنافسة العالمية ويضعف من فرص الاعتراف بالشهادات الأردنية دوليًا.
• ضعف توظيف نتائج التقييم في التطوير: حتى عندما تُجرى عمليات تقييم جودة، غالبًا لا تُترجم نتائجها إلى إجراءات تطويرية ملموسة، إما بسبب ضعف الإرادة المؤسسية، أو بسبب محدودية الموارد المالية والبشرية.
• التركيز على الجوانب الشكلية: تنشغل بعض الجامعات بتجهيز ملفات الاعتماد الورقية أو الإلكترونية لتلبية المتطلبات الشكلية، دون العمل فعليًا على تطوير المحتوى التعليمي، أو تدريب الكادر، أو تحسين بيئة التعلم.
الفروقات بين الجامعات الرسمية والخاصة في هذا التحدي
الجامعات الرسمية:
• تمتلك إرثا أكاديميا قويا، وكفاءات بشرية عالية، لكن تعاني من بيروقراطية مؤسسية تؤخر عمليات التطوير، وضعف التمويل الذي يؤثر على تنفيذ خطط الجودة.
• بعض الجامعات الرسمية تتأخر في تحديث البرامج الأكاديمية، وفي تطوير وسائل التدريس، ما يؤثر على تلبية متطلبات الجودة الحديثة.
الجامعات الخاصة:
• تميل إلى مرونة إدارية أعلى، وسرعة في التحديث، لكنها أحيانا تركّز على الربحية على حساب الجودة الأكاديمية.
• في بعض الحالات، يتم توظيف أعضاء هيئة تدريس بشكل مؤقت أو جزئي مما يضعف الاستقرار الأكاديمي ويؤثر على بناء منظومة جودة حقيقية.
الأسباب الجذرية للتحدي
• محدودية الثقافة المؤسسية للجودة: في كثير من الجامعات، لا يُنظر إلى الجودة كقيمة مضافة ومستمرة، بل كمطلب رقابي، مما يجعلها مسؤولية إدارية محدودة وليست مسؤولية تشاركية تشمل جميع العاملين.
• ضعف القدرات الفنية والبشرية: لا تمتلك بعض الجامعات الكوادر المتخصصة في الجودة، أو لا توفّر تدريبًا مستمرًا لهم، مما يجعل وحدات الجودة غير قادرة على أداء دورها بفعالية.
• غياب الربط بين التقييم والمساءلة: غالبًا لا يتم ربط نتائج تقييم الجودة (مثل أداء التدريس أو رضا الطلبة) بقرارات إدارية حقيقية كالمكافآت أو الترقيات أو تطوير المناهج.
• محدودية التمويل المخصص للجودة: الاعتماد والجودة يحتاجان إلى موارد مالية لتطوير البنية التحتية، وتدريب الكوادر، وشراء برمجيات متخصصة، وهو ما يصعب توفيره في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها معظم الجامعات.
• ضعف الشراكات الأكاديمية الدولية: الانخراط في شبكات الجودة الدولية يساعد على تبادل الخبرات ورفع المعايير، لكن العديد من الجامعات الأردنية لم تبنِ علاقات كافية على هذا الصعيد.
الآثار السلبية لضعف الاعتماد والجودة
• تراجع سمعة الجامعات الأردنية: يؤدي ضعف الجودة إلى فقدان الثقة في مخرجات الجامعات محليًا وعربيًا، ويُضعف من قدرتها على استقطاب الطلبة الدوليين أو التعاقد مع مؤسسات دولية.
• محدودية توظيف الخريجين: عندما لا تُطابق البرامج الأكاديمية معايير الجودة المرتبطة بسوق العمل، يصبح الخريجون أقل قدرة على التنافس محليًا وخارجيًا، ما يفاقم مشكلة البطالة.
• ضعف التصنيفات العالمية: تأخذ التصنيفات الدولية مثل QS وTimes Higher Education معايير الجودة والاعتماد بعين الاعتبار، وضعف الأداء في هذا المجال يُبقي الجامعات الأردنية في مراتب متأخرة.
• إهدار الموارد: عندما لا تُوظف عمليات الاعتماد والتقييم في التطوير الفعلي، تتحول إلى جهد إداري لا يُنتج أثرًا حقيقيًا، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمال.
توصيات لمعالجة التحدي
ترسيخ ثقافة الجودة في الجامعات: نشر الوعي بأهمية الجودة والاعتماد كممارسة تطويرية مستمرة، وليس كمتطلب إداري، وتوسيع المشاركة في أنشطة التقييم والتحسين.
تطوير وحدات الجودة المؤسسية: تمكين وحدات الجودة بالكوادر المؤهلة، والموارد التقنية، والتفويض الإداري، لتصبح قادرة على قيادة عمليات التقييم والتطوير بفاعلية.
ربط الجودة بالتخطيط الاستراتيجي: دمج مؤشرات الأداء والجودة في الخطط الاستراتيجية للجامعة، وربط نتائج التقييم بالتطوير المؤسسي والقرارات الكبرى.
التحفيز على الاعتماد الدولي: تشجيع الكليات والبرامج على التقدم للاعتمادات الدولية، وتقديم دعم فني وتمويلي لها، بما يعزز الاعتراف الدولي بمخرجاتها.
توظيف التكنولوجيا في الجودة: استخدام أنظمة إلكترونية لجمع البيانات وتحليل الأداء الأكاديمي، وتفعيل منصات تقييم الطلبة، والربط مع قواعد بيانات وطنية وإقليمية.
تعزيز الشفافية والمساءلة: نشر تقارير الجودة بشكل دوري، وإشراك الطلبة والخريجين وأصحاب العمل في تقييم البرامج وتحسينها، وخلق آليات رقابة ومساءلة داخلية.
بناء شراكات إقليمية ودولية: التعاون مع مؤسسات جودة إقليمية مثل اتحاد الجامعات العربية أو AQAC، والانضمام إلى شبكات الجودة العالمية لتبادل أفضل الممارسات.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
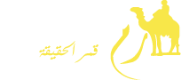
 الرد على تعليق
الرد على تعليق