لا يوجد تعليقات
رؤية التحديث: طموح مشروع يواجه اختبار التنفيذ
رم - الدكتور ليث عبدالله القهيوي
يقترب الاردن من منتصف الطريق في تنفيذ «رؤية التحديث» التي وُلدت في صيف 2022 على وقع تكليفٍ ملكيٍّ بتجديد البنية الاقتصادية والسياسية والإدارية للبلاد خلال عقد كامل. لكن مرور عامين ونصف العام كشف أنّ الرهان الحقيقي لم يكن صياغة الوثيقة ولا حتى تأمين المخصصات التي تخطّت المليار دينار، بل القدرة على تحويل الأرقام والبنود إلى أثرٍ نوعي يراه المواطن في دخله وخدماته وثقته بمؤسسات الدولة. فالحكومة تعلن أنها أنجزت 28 % من أولويات البرنامج التنفيذي بحلول الربع الأول من 2025، وهو رقم يبدو نظرياً باعثاً على الطمأنينة، غير أنّ جدواه تتضاءل ما لم يترجم إلى فرص عمل مستدامة ونموٍّ في الأجور وتحسُّنٍ ملموس في جودة التعليم والصحة والنقل العام.
على الصعيد الاقتصادي، يحسب للحكومة أنها كسرت جموداً تشريعياً طويل الأمد حين أقرّت قانون البيئة الاستثمارية وطوّرت إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أعاد شيئاً من الحيوية إلى مؤشرات الصادرات والسياحة وتسجيل الشركات الجديدة. كذلك تراجع معدل البطالة بشكل طفيف عن الذروة التي بلغها بعد جائحة كوفيد‑19، ما يعكس تحريكاً محدوداً لعجلة العمل. إلا أنّ هذه النجاحات المبكّرة تُضمر هشاشة هيكلية تتمثّل في التركز المفرط لقطاعات النمو في جغرافيا العاصمة ، وفي تباطؤ الاستثمارات طويلة الأجل التي تنقل التكنولوجيا وتؤسس لاقتصاد معرفة حقيقي. هنا يطلّ شبح البيروقراطية متعددة الرؤوس التي تُربك المستثمر بمرجعيات متباينة وإجراءات غير مقيسة بزمن، فيما لم تنجح «النوافذ الموحدة» في كسر ثقافة الورق أو فرض معيار أداء مرتبِط بالحوافز والمساءلة. ومن دون ثورة إدارية توازي الثورة التشريعية، سيبقى رأس المال عابراً يبحث عن أسواق أقل احتكاكاً وأكثر يقيناً.
في المقابل، دخل الحقل السياسي مرحلة جديدة حين أُقِرَّ قانونا الأحزاب والانتخاب المعدَّلان عام 2022، فجرى توسيع التمثيل البرامجي وتخصيص مقاعد على مستوى القوائم الوطنية، وارتفع عدد المنتسبين للأحزاب إلى ما يقارب 86 ألف شخص بعد اندماج عشرات الكيانات الصغيرة وهو رقم خجول ولا يلبي الطموح . وعلى ذلك، لم تتجاوز نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في آخر انتخابات عامة 32 %، ما يشير إلى فجوة ثقة واضحة بين التشريعات الطموحة ووجدان الشارع. الخطورة هنا ليست في ضعف المشاركة فحسب، بل في احتمال تحوّل الإصلاح إلى هندسة شكلية تُسقِط التعددية في فخّ التزيين إن لم تُرفَد بضمانات حرية العمل السياسي داخل الجامعات والنقابات، وشفافية تمويل تُبعد الأحزاب عن شبهة المال السياسي، وعدالة نفاذ إلى الإعلام تتيح طرح البرامج على أسماع الناس وأبصارهم بلا وصاية أو إقصاء.
تقدُّم المحور الاجتماعي والإداري بدا للوهلة الأولى أكثر وضوحاً: مراكز خدمات حكومية شاملة افتتحت أبوابها، ومنصات إلكترونية جديدة بسطت خدمات تجديد الجوازات والرخص ودفع الفواتير بلمسة هاتف، وبرنامج دعم نقدي مباشر توسّع ليشمل فئات جديدة، بينما خطت وزارة الصحة الخطوة الأولى نحو تغطية صحية شاملة. غير أنّ الرحلة من الشاشة إلى الشارع كشفت تفاوتاً حادّاً؛ فالخدمة الرقمية لا تعني الشيء الكثير حين يضطر المواطن إلى السفر مئات الكيلومترات للحصول على تشخيص متخصّص، أو حين يقف طالبٌ في مدرسة مكتظة يفتقر معلّمها إلى تدريب مستمر. وما دامت آلية المتابعة والتقييم تكتفي بقياس الإنجاز على أساس عدد المنشآت أو عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً من دون مؤشّر واضح على رضى المنتفع، فإن الفجوة بين الإنجاز المعلن والواقع المعاش ستظل تتسع.
هنا تبرز ضرورة تعديل البوصلة من «كم أنجزنا؟» إلى «كيف انعكس ما أنجزنا؟». المطلوب أولاً تحويل نسب التنفيذ إلى مؤشرات أثر: وظيفة جديدة لكل شاب، أو دينار دخل إضافي للأسر، أو دقيقة تُقتطع من زمن معاملة رسمية. المطلوب ثانياً مأسسة الحوكمة وربط الحوافز بأداء قابل للقياس، بحيث يُكافأ الموظف على سرعة الإنجاز وجودته، لا على مجرد الحضور والانصراف. المطلوب ثالثاً تغذية المشهد الحزبي بثقافة مشاركة تُبنَى من مقاعد المدارس و الجامعات ومجالس البلديات والادارة المحلية ، وتدفع الشباب والنساء إلى قلب العملية السياسية لا هوامشها. رابعاً، يتعيّن بناء رقابة مجتمعية رقمية تُمكِّن المواطن من تقييم الخدمة علناً، وتُلزم الإدارة بالاستجابة السريعة لإصلاح الخلل أو الاعتذار عنه. وأخيراً يجب إعادة الاعتبار إلى الأطراف عبر حوافز ضريبية وشراكات بنية تحتية حقيقية تجذب الصناعات والتكنولوجيا خارج العاصمة، فيتحقق شعار «التنمية العادلة» بالفعل لا بالخطاب.
إن «رؤية التحديث» مشروع وطني لا ترفَ في تأجيله في بيئة إقليمية متقلبة واقتصاد عالمي يتسارع إلى رقمنةٍ وأتمتةٍ لا تنتظر المتعثّرين. غير أنّ نجاح هذا المشروع سيظل رهين قدرته على أن يشعر الأردني العادي بأن غدَهُ أفضل من أمسه، وأن الضريبة التي يدفعها أو الورقة التي يوقّعها تتجسّد في خدمة أيسر وفرصة أوفر واحترام أعمق. فالتاريخ لن يكتفي بتوثيق نسب التنفيذ؛ هو يُحصي أيضاً معدَّلات الرضا، ويقارن بين الخطط الكبيرة والإنجازات الصغيرة التي تمس تفاصيل الحياة اليومية. النقد البنّاء، إذن، ليس تهجماً على الرؤية، بل شرط بقائها حية؛ يضغط لتسريع التنفيذ، ويطالب بالشفافية، ويكفل أن تُقسَّم ثمار التحديث بعدالة على سكان العاصمة والمفرق ومعان والبادية على حدٍّ سواء. وإن لم يتحقق ذلك، فإن الأوراق الرسمية، مهما تزركشت بالألوان والأرقام، ستغدو هامشاً في سجلّ تطورات لم يشعر بها أصحاب الشأن الحقيقيون: المواطنون.
يقترب الاردن من منتصف الطريق في تنفيذ «رؤية التحديث» التي وُلدت في صيف 2022 على وقع تكليفٍ ملكيٍّ بتجديد البنية الاقتصادية والسياسية والإدارية للبلاد خلال عقد كامل. لكن مرور عامين ونصف العام كشف أنّ الرهان الحقيقي لم يكن صياغة الوثيقة ولا حتى تأمين المخصصات التي تخطّت المليار دينار، بل القدرة على تحويل الأرقام والبنود إلى أثرٍ نوعي يراه المواطن في دخله وخدماته وثقته بمؤسسات الدولة. فالحكومة تعلن أنها أنجزت 28 % من أولويات البرنامج التنفيذي بحلول الربع الأول من 2025، وهو رقم يبدو نظرياً باعثاً على الطمأنينة، غير أنّ جدواه تتضاءل ما لم يترجم إلى فرص عمل مستدامة ونموٍّ في الأجور وتحسُّنٍ ملموس في جودة التعليم والصحة والنقل العام.
على الصعيد الاقتصادي، يحسب للحكومة أنها كسرت جموداً تشريعياً طويل الأمد حين أقرّت قانون البيئة الاستثمارية وطوّرت إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي أعاد شيئاً من الحيوية إلى مؤشرات الصادرات والسياحة وتسجيل الشركات الجديدة. كذلك تراجع معدل البطالة بشكل طفيف عن الذروة التي بلغها بعد جائحة كوفيد‑19، ما يعكس تحريكاً محدوداً لعجلة العمل. إلا أنّ هذه النجاحات المبكّرة تُضمر هشاشة هيكلية تتمثّل في التركز المفرط لقطاعات النمو في جغرافيا العاصمة ، وفي تباطؤ الاستثمارات طويلة الأجل التي تنقل التكنولوجيا وتؤسس لاقتصاد معرفة حقيقي. هنا يطلّ شبح البيروقراطية متعددة الرؤوس التي تُربك المستثمر بمرجعيات متباينة وإجراءات غير مقيسة بزمن، فيما لم تنجح «النوافذ الموحدة» في كسر ثقافة الورق أو فرض معيار أداء مرتبِط بالحوافز والمساءلة. ومن دون ثورة إدارية توازي الثورة التشريعية، سيبقى رأس المال عابراً يبحث عن أسواق أقل احتكاكاً وأكثر يقيناً.
في المقابل، دخل الحقل السياسي مرحلة جديدة حين أُقِرَّ قانونا الأحزاب والانتخاب المعدَّلان عام 2022، فجرى توسيع التمثيل البرامجي وتخصيص مقاعد على مستوى القوائم الوطنية، وارتفع عدد المنتسبين للأحزاب إلى ما يقارب 86 ألف شخص بعد اندماج عشرات الكيانات الصغيرة وهو رقم خجول ولا يلبي الطموح . وعلى ذلك، لم تتجاوز نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في آخر انتخابات عامة 32 %، ما يشير إلى فجوة ثقة واضحة بين التشريعات الطموحة ووجدان الشارع. الخطورة هنا ليست في ضعف المشاركة فحسب، بل في احتمال تحوّل الإصلاح إلى هندسة شكلية تُسقِط التعددية في فخّ التزيين إن لم تُرفَد بضمانات حرية العمل السياسي داخل الجامعات والنقابات، وشفافية تمويل تُبعد الأحزاب عن شبهة المال السياسي، وعدالة نفاذ إلى الإعلام تتيح طرح البرامج على أسماع الناس وأبصارهم بلا وصاية أو إقصاء.
تقدُّم المحور الاجتماعي والإداري بدا للوهلة الأولى أكثر وضوحاً: مراكز خدمات حكومية شاملة افتتحت أبوابها، ومنصات إلكترونية جديدة بسطت خدمات تجديد الجوازات والرخص ودفع الفواتير بلمسة هاتف، وبرنامج دعم نقدي مباشر توسّع ليشمل فئات جديدة، بينما خطت وزارة الصحة الخطوة الأولى نحو تغطية صحية شاملة. غير أنّ الرحلة من الشاشة إلى الشارع كشفت تفاوتاً حادّاً؛ فالخدمة الرقمية لا تعني الشيء الكثير حين يضطر المواطن إلى السفر مئات الكيلومترات للحصول على تشخيص متخصّص، أو حين يقف طالبٌ في مدرسة مكتظة يفتقر معلّمها إلى تدريب مستمر. وما دامت آلية المتابعة والتقييم تكتفي بقياس الإنجاز على أساس عدد المنشآت أو عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً من دون مؤشّر واضح على رضى المنتفع، فإن الفجوة بين الإنجاز المعلن والواقع المعاش ستظل تتسع.
هنا تبرز ضرورة تعديل البوصلة من «كم أنجزنا؟» إلى «كيف انعكس ما أنجزنا؟». المطلوب أولاً تحويل نسب التنفيذ إلى مؤشرات أثر: وظيفة جديدة لكل شاب، أو دينار دخل إضافي للأسر، أو دقيقة تُقتطع من زمن معاملة رسمية. المطلوب ثانياً مأسسة الحوكمة وربط الحوافز بأداء قابل للقياس، بحيث يُكافأ الموظف على سرعة الإنجاز وجودته، لا على مجرد الحضور والانصراف. المطلوب ثالثاً تغذية المشهد الحزبي بثقافة مشاركة تُبنَى من مقاعد المدارس و الجامعات ومجالس البلديات والادارة المحلية ، وتدفع الشباب والنساء إلى قلب العملية السياسية لا هوامشها. رابعاً، يتعيّن بناء رقابة مجتمعية رقمية تُمكِّن المواطن من تقييم الخدمة علناً، وتُلزم الإدارة بالاستجابة السريعة لإصلاح الخلل أو الاعتذار عنه. وأخيراً يجب إعادة الاعتبار إلى الأطراف عبر حوافز ضريبية وشراكات بنية تحتية حقيقية تجذب الصناعات والتكنولوجيا خارج العاصمة، فيتحقق شعار «التنمية العادلة» بالفعل لا بالخطاب.
إن «رؤية التحديث» مشروع وطني لا ترفَ في تأجيله في بيئة إقليمية متقلبة واقتصاد عالمي يتسارع إلى رقمنةٍ وأتمتةٍ لا تنتظر المتعثّرين. غير أنّ نجاح هذا المشروع سيظل رهين قدرته على أن يشعر الأردني العادي بأن غدَهُ أفضل من أمسه، وأن الضريبة التي يدفعها أو الورقة التي يوقّعها تتجسّد في خدمة أيسر وفرصة أوفر واحترام أعمق. فالتاريخ لن يكتفي بتوثيق نسب التنفيذ؛ هو يُحصي أيضاً معدَّلات الرضا، ويقارن بين الخطط الكبيرة والإنجازات الصغيرة التي تمس تفاصيل الحياة اليومية. النقد البنّاء، إذن، ليس تهجماً على الرؤية، بل شرط بقائها حية؛ يضغط لتسريع التنفيذ، ويطالب بالشفافية، ويكفل أن تُقسَّم ثمار التحديث بعدالة على سكان العاصمة والمفرق ومعان والبادية على حدٍّ سواء. وإن لم يتحقق ذلك، فإن الأوراق الرسمية، مهما تزركشت بالألوان والأرقام، ستغدو هامشاً في سجلّ تطورات لم يشعر بها أصحاب الشأن الحقيقيون: المواطنون.
عدد المشاهدات : (8868)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
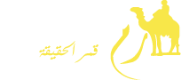
 الرد على تعليق
الرد على تعليق